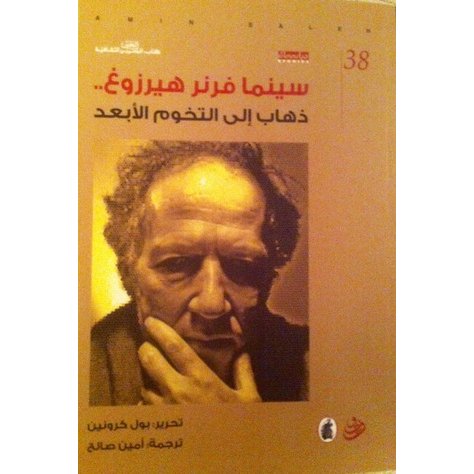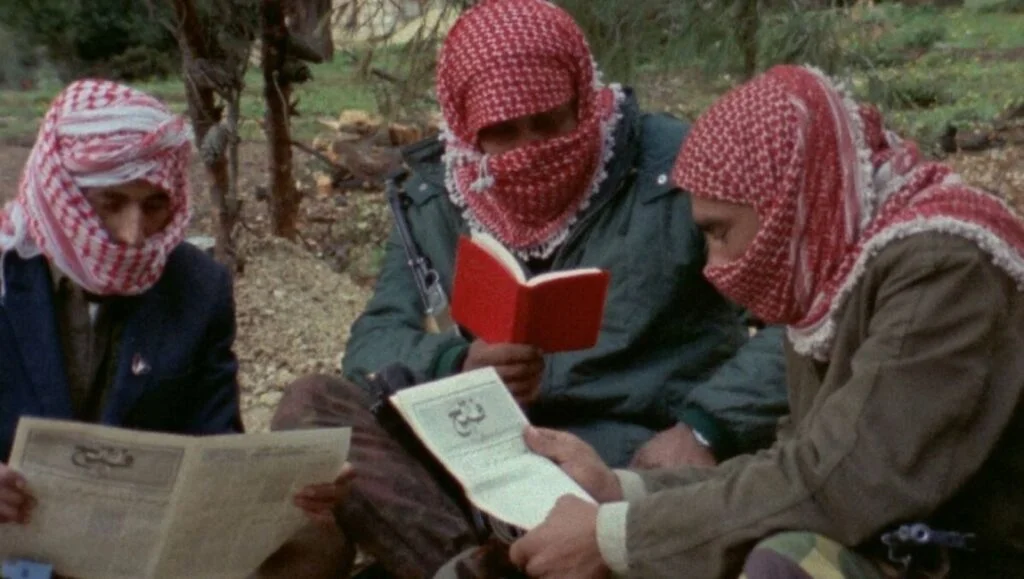ذكريات حول تجربة نادي السينما

كان نادي القاهرة للسينما مشروعا طموحا من مشاريع وزارة الثقافة في عصر الوزير ثروت عكاشة. وأظن أن الفكرة ولدت من رحم حالة الزخم السينمائي الذي شهدته مصر بعد هزيمة 1967.
كانت هناك حالة من المراجعة الثقافية والسياسية التي اجتاحت البلاد، وشغلت المثقفين تحديدا، بالبحث في أسباب الهزيمة، والرغبة العارمة في التحرر من الثقافة التقليدية العتيقة، والتطلع إلى ثقافة أخرى، أكثر حداثة، وأكثر تعبيرا عن التحولات العضوية التي وقعت داخل “الانتلجنسيا” المصرية في علاقتها بالطبقة الوسطى، وبالسلطة.
وكانت هناك رغبة في تطوير السينما، ومد تجربة تدخل الدولة في الإنتاج والتوزيع والعرض من خلال ما عرف بـ”القطاع العام السينمائي”، على استقامتها، والتطلع أيضا إلى ربط العملية الإنتاجية، بالعملية الثقافية، أي إتاحة الفرصة لظهور ثقافة سينمائية جديدة يمكنها أن تساهم في تطوير الذوق والوعي بحيث تتغير نظرة الجمهور في تعامله مع الفيلم. ولاشك لدي في أن وراء هذه الرؤية كان يقف عدد من المثقفين والنقاد الذين أرادوا تطوير تجربة “جمعية الفيلم” (التي تعد الكيان الثقافي السينمائي الأعرق في مصر فقد تأسست عام 1960)، لكن لاشك لدي أيضا في أن النظرة الرسمية للدولة الناصرية وقتها، تلاقت مع رغبة النقاد في الانفتاح السينمائي على التيارات الحديثة والتجارب السينمائية الجديدة في العالم، ولكن ليس بغرض التطوير والتثقيف وزيادة الوعيفقط، بل أيضا لاستيعاب واحتواء حركة السينمائيين الجدد من الشبان الغاضبين الذين كانوا قد نجحوا في تأسيس “جماعة السينما الجديدة”، وأخذوا يطالبون بـ”حصة” مناسبة من مخصصات الإنتاج السينمائي في “القطاع العام”، أي من خلال مؤسسة السينما الحكومية التي كانت تنتج عددا لا بأس به من الأفلام سنويا، لم تكن بالضرورة كلها من الأفلام الجيدة، بل كان فيها أيضا ما عرف بـ”أفلام حرف ب”، على غرار ما كان سائدا في هوليوود، وهي أفلام كان هدفها الأساسي تجاريا، ولم يكن هناك مانع بالتالي من ظهور أفلام مثل “شنبو في المصيدة” و”من أجل حنفي” و”الزوج العازب” وغيرها!
وكان الصراع بين القديم والجديد قد انفجر في المجتمع المصري في تلك الفترة التي عرفت أيضا نشاطا كبيرا وزخما في إصدار المجلات الثقافية مثل “الفكر المعاصر” و”المجلة” و”الكاتب” و”الطليعة”، وغيرها.
كانت الدولة تسعى إلى الاحتواء، وربما أيضا إلى نوع من “الأدلجة”، أي السيطرة الأيديولوجية على المثقفين بتياراتهم المختلفة التي كانت تميل في ذلك الوقت تحديدا، إلى اليسار، حتى لا تفلت الأمور من بين أيدي سلطة كانت تشعر بحجم الغضب الكامن في الصدور، وكان “التنفيس والاحتواء وتقديم بعض التنازلات المحكومة” أفضل ما تملك تقديمه، فلم يكن ممكنا مثلا أن تترك تجمعات السينمائيين تتخذ لنفسها مسارا خاصا، بل سعت السلطة إلى ربطها من البداية بالدولة، وبالسلطة الثقافية من خلال وزارة الثقافة، ولكن بحصافة وذكاء ومنح بعض التنازلات في الطريق، وليس باتباع سياسة العصا والجزرة، ورفع شعارات فجة مثل “إدخال المثقفين إلى الحظيرة”، كما حدث بعد ذلك في عهد آخر مختلف تمام الاختلاف!
تأسس “نادي السينما” في هذا المناخ، وأداره في البداية الناقد مصطفى درويش، عندما كان يقدم عروضه في موسمه الأول (1968) في قاعة “إيوارت” بالجامعة الأمريكية. وكان مصطفى درويش رقيبا سابقا وفي الوقت نفسه، قاضيا في مجلس الدولة.
والطريف أنه عندما فتح النادي أبوابه للعضوية تقدم للحصول على عضويته أكثر من خمسة آلاف عضو، تحت تصور أن النادي سيعرض “الأفلام الممنوعة”، بكل ما يمكن فهمه بالطبع من كلمة “ممنوعة” هنا، والمقصود الأفلام التي تتضمن مناظر مثيرة.

إلا أن الوزارة أوضحت أن الهدف من تأسيس نادي السينما ليس عرض أفلام ممنوعة، بل عرض الأفلام ذات القيمة الفنية الرفيعة، ولذلك رفض النادي قبول مئات الطلبات واكتفي بنحو ألف عضو، ارتفع بعد ذلك إلى نحو ألفي عضو، عندما أصبح يعرض أكثر من عرض واحد، في سينما أوبرا، وفي قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية أو قاعة النيل. وكان هذا العدد كبيرا جدا بمقاييس نوادي السينما في العالم التي لم يكن يزيد عدد عضوية كل منها عادة عن 300 عضو.
في العام الأول من عمر النادي (1968) كانت العروض، كما ذكرت، تقام في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية. وفي العام التالي انتقلت عروض النادي إلى سينما أوبرا في وسط القاهرة، في واحد من أجمل الميادين، وهو ميدان الأوبرا أو ابراهيم باشا سابقا، حينما كانت “الأوبرا” القديمة التي أنشأها الخديوي اسماعيل، مؤسس القاهرة الحديثة (تعرف أيضا بالقاهرة الاسماعيلية) لاتزال قائمة قبل احتراقها أو حرقها في أكتوبر من عام 1972. وكان يجاور سينما أوبرا “كازينو صفية حلمي” الذي يعتبر جزءا من تاريخ الفن الغنائي في مصر، وكان الميدان مفتوحا، يتمتع بالرونق والسحر والجمال، تتفرع منه الشوارع الرئيسية الشهيرة: ابراهيم باشا (الذي أطلق عليه شارع الجمهورية) وفيه سينما “حديقة النصر” الصيفية التي شاهدنا فيها عشرات الروائع السينمائية العالمية، وشارع فؤاد الأول (26 يوليو)، وشارع عبد الخالق ثروت. وفي الركن الأيسر من الميدان كان هناك سور الأزبكية الأسطوري التي لاتزال ذكراه قائمة حتى يومنا هذا.
كان الاتفاق بين نادي السينما ودار سينما أوبرا، على تخصيص حفلة المساء من كل أربعاء لعروض النادي.
وكنا نلتقي أمام مدخل سينما أوبرا، مساء كل أربعاء، مع عشرات الشخصيات المرموقة من النخبة المثقفة. وكان النقاد والسينمائيون الشباب أيضا يتجمعون ويتناقشون مناقشات طويلة تسبق الدخول لمشاهدة العرض، حيث كان يتولى أحد النقاد تقديم الفيلم، على أن تعقب العرض مناقشة مفتوحة كانت تستمر أحيانا إلى ما بعد منتصف الليل.
وقد تخرج من نادي السينما الكثير من النقاد والسينمائيين أيضا، أي الشباب الذين اتجهوا لدراسة السينما، بعد أن تشبعوا بثقافتها، وتعلموا أبجديات السينما من خلال المشاهدة والتحليل أولا، قبل استكمال الدراسة العملية.
وأعتقد أن انتهاء دور نوادي السينما في العالم، وليس في مصر فقط، وتضاؤل أهمية ما ظل قائما منها، يعود أساسا، إلى الانتشار الهائل للفيديو أولا، ثم للأسطوانات المدمجة (DVD) التي وفرت الفرصة للشباب لمشاهدة ما يرغبون، بل أدى انتشار الانترنت أيضا إلى أن أصبح الكثير من الأفلام الفنية متاحا عبر الشبكة العالمية للانترنت، ويمكن أيضا تحميله على جهاز الكومبيوتر ومشاهدته وإعادة مشاهدته مرات ومرات. وربما يرجع الأمر أيضا إلى تراجع فكرة الثقافة في محيط جماعي، بعد أن انتشرت القيم الفردية الانعزالية لدى الشباب.
لكن ينبغي أن أقول إن المشاهدة في “نادي السينما” تختلف تماما عن مشاهدة الأفلام على شاشة الكومبيوتر المنزلي، فالفيلم مكانه الطبيعي يظل في قاعة السينما، أي على الشاشة الكبيرة، ولا يمكن أن ترقى مشاهدة الأفلام في غرفة صغيرة بشكل فردي تماما إلى طقس المشاهدة الجماعية وسط جمهور. أضف إلى ذلك بالطبع، وجود نشرة مطبوعة حول الفيلم المعروض، والمناقشات الثرية التي تعقب العروض، وتتيح الفرصة للاستماع إلى الآراء المختلفة. ومن الجدل الذي يدور، يستفيد المرء ويكون صورة أكثر وضوحا، سواء عن الفيلم، أو عن ثقافة الناقد الذي يتولى إدارة المناقشة.
(للموضوع بقية)…
تعليقات القراء