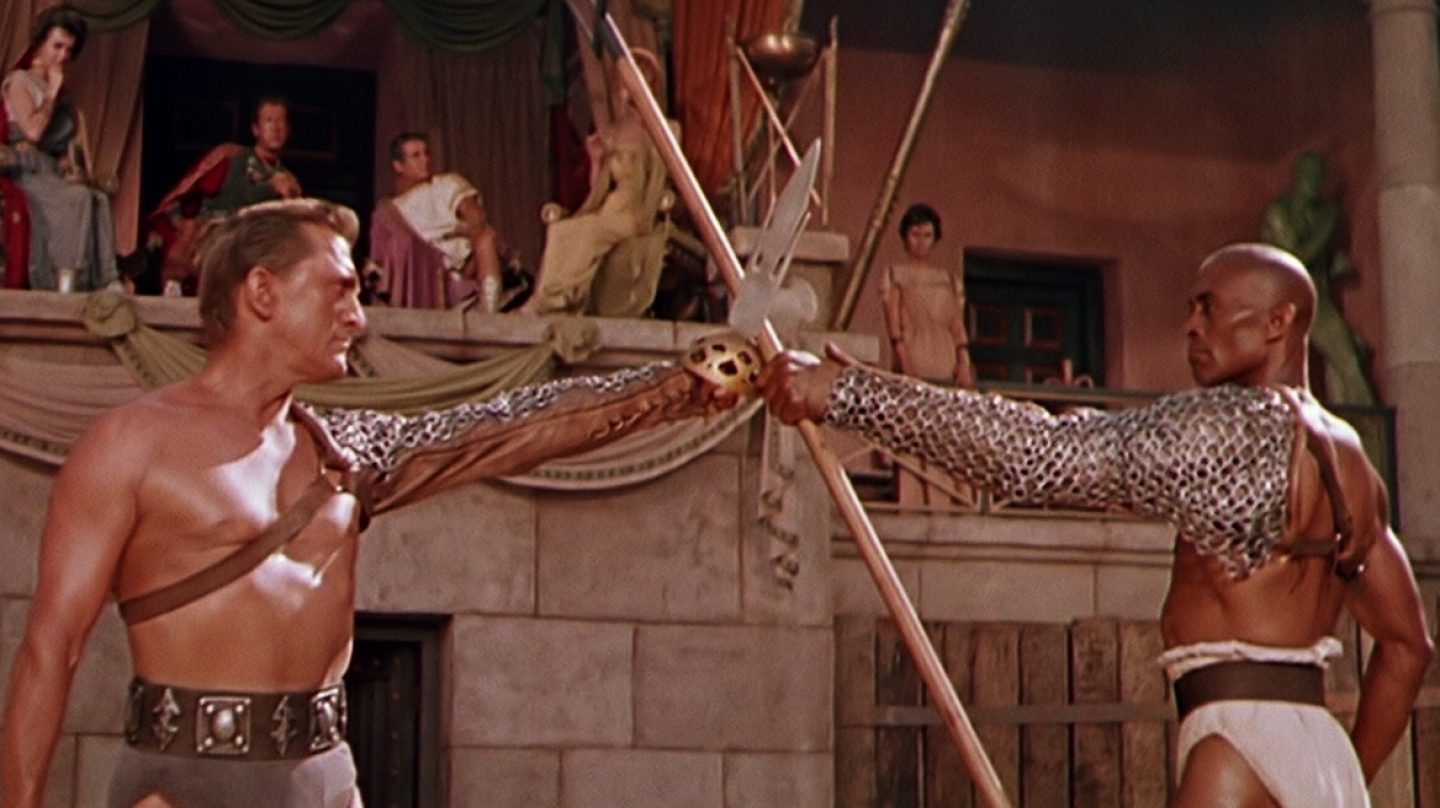“جمل البروطة”: عندما نتعاطف مع المطحونين رغم كونهم لصوصا!

فيلم جديد في رؤيته، في مضمونه وإنسانيته، في قدرته على أن يغرس الحيرة في قلبك وعقلك، في أن يجعلك تتعاطف مع هؤلاء البشر الكادحين المحرومين والمطحونين رغم أنهم مارسوا السرقة والنهب والحرق والتكسير، رغم أنهم ليسوا فقط ضد حقوق المرأة ولكنهم أيضاً خدعوا النساء واحتالوا على الفتيات، تتعاطف معهم لأن إحساسك الدفين يخبرك أنهم ضحايا لهذا المجتمع الظالم الذي يستغلهم ويسلبهم أدميتهم، مجتمع لا يكتفي بأن لا يمنحهم أبسط حقوقهم، ولكنه أيضاً لا يتركهم إلا عندما يُصبحوا حطاماً أو بقايا بشر مهزومين، وهو في ذلك يتشابه مع مجتمعات أخرى، عربية وغير عربية.
يمكن وصف مخرجه التونسي الشاب حمزة عوني بالمثقف العضوي، فهو يتتبع طوال فيلمه “جمل البروطة” أو “الجورت” حياة ثمانية من عمال “الجراتا” أي عمّال شاحنات التبن التي تجوب الأراضي التونسية ذهاباًوإيابا، لكنه يغوص بشكل أكثر عمقاً في حياة اثنين منهما، وشوشة وخيري، إذ تربطبينهما علاقة صداقة حميمة كأنهما توأم، يتفاعل معهما حمزة، يدافع عنهما، يحثهما على التفكير والتغيير، فيتشجعان للحديث بصدق وصراحة عن أدق خصوصيات حياتهما فوق وتحت الأرض، يبوحان بمعتقداتهما وزلاتهما، وأخطائهما، يعترفان بعلاقتهما مع النساء، عن واقعة الاعتداء الجنسي علي أحدهما من شخص مثلي، يتحدثان عن الطريق ومخاطره ومُتعه الحسية القليلة التي لا يملكان غيرها حيث تُباع المشروبات الكحولية وتتصيدهم المومسات بأساليب تُتقنها.
في إحدى اللحظات يعترف خيري بواقعة سرقته لبطارية، ولما يسأله المخرج حمزة: “ولماذا فعلت هذا”؟ يجيبه الشاب: “لأنه لم يكن معي فلوس..” يلومه حمزة بعتاب: “يا خيري.. فيه ناس كثيرة فقراء وليس معهم فلوس لكنهم لا يسرقون”.. هنا يندفع خيري بغضب: “لا تخطيء في حقي.. هنا، في المحمدية الناس كلها تسرق، خصوصا في الشتاء، عندما لا تجد عملا تتحول الناس إلى لصوص. هو أمر وراثي..” فيقاطعه حمزة: “والدي هو أيضاً كان يعمل مثلكم في التبن، لكنه لم يسرق…” عندئذ يتدخل وشوشة فجأة ليقول بحسم: “والدك كان حرامي ويسرق….” فيتبعه خيري قائلاً بهدوء ولطف: “والدك الله يرحمه.. لكنه أكيد سرق، ولو قليلاً. إنها الوراثة.. والدك، والدي، أنا، والأجيال القادمة”.
لم يحذف حمزة تلك الإهانة أو الاتهام في ذلك الجزء الحواري القاسي والمهم – من بين أجزاء حوارية أخرى أشد قسوة – من شريطه السينمائي “جمل البروطة”، بل تركها وواصل إنصاته إليهما بصدر رحب دون أن يرد على الاتهام باتهام أخر، فيأتيه صوت وشوشة: “أشعر أني رجل ضائع، ولم أفعل شيء بحياتي. أليس التبن هو حياتنا..؟!! لا يوجد مستقبل لنا، فلو جُرحت أنا ماذا سيكون مصيري؟” فيجيبه حمزة: “هذا اختيارك.” ينفي وشوشة: “لم اخترها”. حمزة: “أنت تراها مهنة غير جيدة لكنك مستمر فيها…” فيرد عليه الشابين في صوت واحد: تأمل حالك.. أنت مريض بالسينما ولا تفكر إلا فيها، ونحن مرضى بالتبن..”.
بداية ونهاية
يبدأ الفيلم من ظلام دامس لا نسمع خلاله سوى صوت طرقات قوية بحجر على باب من الصاج لبضع ثوان، بينما في الخلفية الصوتية يأتينا بين لحظة وأخرى صوت نباح الكلاب، وكأن تلك الطرقات ما هي إلا جرس إنذار أو أداة تنبيه – للمجتمع وللمسؤولين وللمثقفين – لكل ما سيأتي من حقائق مؤلمة، وكأنه إنذار يُؤكد العنوان برمزيته الموجعة، فما أقوى الشبه بين حالة هؤلاء الكادحين وبين “جمل البروطة” الذي تتلخص كل مهمتهُ في الدوران حول البئر، معصوب العينين، لاستخراج المياه. يقضي هذا الجمل سنوات حياته في الدوران إلى أن يُصبح غير قادرٍ على العمل، فيتم ذبحه، واستبداله بآخر. والمجتمع نفسه يُشبه أيضاً هذا الجمل في حركة دورانه اللانهائية، كأنه يدور في حلقة مفرغة وهو الأمر الذي يخلق الحيرة والقلق ويجعلنا نتساءل: هل يمكن إصلاح هذا الوضع اللاإنساني؟ هل هناك أي بارقة أمل؟ ومن أين تأتي البداية؟ على صعيد آخر فإن كلمة “الجورت” والتي تعني التبن أو القش باللهجة التونسية، لكنها كتبت بحروف لاتينية أسفل العنوان العربي على التتر وكأنها مرادف “لجمل البروطة” وهى إشارة شديدة الذكاء من المخرج يُؤكد بها على الرمزية المقصودة والمعنى الحقيقي للفيلم، فعمال الجراتا مثل جمل البروطة ومرادف له.
يختتم الفيلم بأغنية تقول كلماتها: هذا البلد يثير اشمئزازي/ فالحصول على الخبز فيه هو نوع من الخطر/ بصدق، سينتهي بي المطاف في السجن/ في باريس سأعيش جيداً/ في بلادي أعاني البؤس والبطالة/ لا يوجد شيء أكله/ لذلك سوف أعمل في المحطات وأحمل الحقائب لأنه في المحمدية ليس لي شيء.

أثناء كلمات الأغنية السابقة ينتقل المخرج إلى لقطة ليلية نرى فيها شاحنة وسط الظلام على الطريق تضئ كشافاتها الأمامية وتبدو وكأنها ثابتة في مكانها، بينما الكاميرا تتقدم للأمام وتتركها في الخلف إلى أن تتزايد بينهما الفجوة حتى تصبح السيارة بقعة صغيرة لا نميزها وربما ننساها تماماً كما هو حال هؤلاء البشر.
ما بين البداية والنهاية، ومن خلال الرصد للحياة اليومية بنهارها وليلها، بصيفها وشتائها، نرى ونعرف ونفهم، ندرك حجم المشاكل التي يُعانيها هؤلاء الناس ومخاوفهم من عدم التأمين عليهم، فزميلهم الذي أصابت الحروق أصابعه فشوهتها وأصبحوا يسمونه السرطان، ومع ذلك لايزال يخدم. عندما اشتعلت النيران في الشاحنة حاول إطفاءها فاحترقت أصابعه ولم يتحصل على تأمين مادي يُساعده على أن يقيم مشروعا يعيش من رزقه، لم يحصل على مليم واحد، وهم مثله تماماً ولا واحدا منهما مُؤَمَن عليه. يقول أحدهما: “نحن مثل الشمعة تحترق.. وستظل تحترق حتى تسيح تماماً، وعندها تُلقي بعيدا ويأتون بغيرها، وكذلك نحن، طالما بقينا قادرين على العمل وتحميل الشاحنات نحن بخير، لكن أول ما نكبر لن نستطيع أن نحمل أي “بالات” ولن نكون وقتها صالحين لفعل شيء. العامل في مهنتنا مثل جمل البروطة.”
شجون الأم وهواجسها
لم يكتف حمزة بالإنصات إليهم في أماكن العمل، سواء في المخازن والأجران أو على الطريق وفي الشاحنات التي يقضون فيها ساعات طويلة كالمساجين، رصدهم في الأسواق، والخرابات التي يلجأون إليها ليتواروا عن العيون لاحتساء الشراب، لكنه اقترب أيضاً من أسرة خيري وعائلته فتحدث مع والدته التي حكت عن الأب الذي رحل إلى ليبيا هربا من البؤس والفقر ولم يعد، عن تحمل خيري للمسؤولية، عن ابنها الأصغر القابع في السجن، عن قدرة خيري على أن يحمي نفسه وينجو من رجال الشرطة فلا يدخل الحبس رغم أنه يرتكب جريمة السرقة مراراً. تواصل الحكي عن رغبته وحلمه في الهجرة، عن هواجسها ومخاوفها من موته أو غرقه إذا سافر، عن دعواتها وصلواتها التي أنقذته عندما لم يسافر مع ستة عشر شابا آخرين من زملائه كان مصيرهم جميعاً الغرق. تصمت الأم للحظة كأنها ترى ضررا قد حاق به وتخبئ عينيها بيديها لتداري دموعها وألمها.
على مدار خمس سنوات رافق المخرج حمزة عوني هؤلاء الشباب، منذ 2007 وحتى 2012. تابعهم أثناء نقل “بالات” أعلاف التبن والقش الجافة الى مناطق مختلفة من تونس، وأثناء ذلك كان يبني جسراً من الثقة والتعاطف الإنساني بينه وبينهم، فسمحوا له بتسجيل حياتهم قبل الثورة وبعدها، بالإدلاء بحوارات عفوية. ورغم أن العينة المختارة في الفيلم تنفي مشاركتها في الثورة، بالعكس كان أغلبهم من المخربين الذين حرقوا ونهبوا عندما شاعت الفوضى في أعقاب الثورة، مع ذلك نجح المخرج في أن يقدم للمتلقي وللفن الوثائقي ما يشبه “التحليلي السوسيولوجي” وكشف خبايا ذلك الواقع الاجتماعي الخرب وتلك الظروف التي كان من الحتمي أن تقود الناس إلى الثورة في يوم ما في ظل غياب العدالة الاجتماعية. فهؤلاء الشباب أنفسهم أثناء حواراتهم قبل الثورة يتحدثون في غضب ثوري واعي بحقوقهم فمحمد وشوشة يقول: تحتاج فلوس، لتعمل وإلا ستموت.. هذه خدمة ظالمة، السيارات أكثر من العبيد، إنها وظيفة بلا أمل. فالعملاء/ السماسرة محظوظون فهم يكسبون 100 دينار بدون أن يرفعوا إصبعا واحدا، عند دقات الساعة العاشرة صباحاً يكونون قد كسبوا أموالهم فيعودون إلى بيوتهم،” وهنا ينتقل المخرج بعد هذه الجملة مباشرة على صورة ضخمة معلقة على حائط عمارة للرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكأنه السمسار الأكبر. في حين يواصل وشوشة حديثه في موقع آخر: إن التاجر أو صاحب التبن يفضل للتبن أن يتعفن على أن يبيعه بسعر رخيص، وهو أيضاً يفضل أن نعمل عنده بدون أجر. إنني أفعل الأشياء التي تقودني للجنون، وللسجن، تجعلني أسرق، وأنهب.. انظر لحالي.. هل هذا منظر شاب عنده 23 سنة.. ورغم ذلك نمشي ونحب نخدم ونعمل، لكنهم لا يريدون.. فالحاكم يظلمك، ويضربك في الحبس، ولا يخليك تتنفس.. فماذا نفعل؟ هذه هي تونس.”

عن السعادة وأشياء آخرى
على صعيد أخر يحكي شاب رابع عن اضطراره لممارسة الغش والاحتيال حتى يتمكن من مواصلة الحياة فيقول: “أحياناً “بالات” التبن تكون نصف معفنة المفروض تترمي، لكننا نبيعها بثمانية أو بعشرة دنانير، وهذا مبلغ كبير. هناك دائماً تبن سيء جداً في الشاحنة،” ويشرح تفصيليا بأداء مسرحي عن أسلوبه في الاحتيال والغش قبل أن يعترف: “لست فخوراً بنفسي، لكني أفعل ذلك تحت الضغوط، أشعر بأنني سأنفجر، لو الدنيا تغيرت أنا سوف أتغير، سأنتظر حتى سن الثلاثين، وبعدها سوف أسرق وأنهب وأبيع المخدرات والكحول في السوق السوداء، سأفعل أي شيء.” وهنا يسأله حمزة: “ولماذا تنظر لسن الثلاثين؟” فيجيبه: “الآن لازلت شاباً قادراً على العمل، سأنتظر وأسعى. كثيرون هاجروا بشكل غير شرعي ويتاجرون في المخدرات في إيطاليا وتزوجوا ولا زلت أنا أنتظر.. هل هذه عيشة؟ يوم أجد العمل ويوم لا؟ ثم تسمعهم يقولون لك ولا واحد سيكون جائع.. طيب أنا جائع.. ويقولون لك تونس الخضراء..!” فيسأله حمزة: “هل تحبها؟” فيقول الشاب بحزن وغصة تهزه: ما نحبهاش يا ولدي.” ثم يحكي عن أسباب كرهه للبلد، والرغبة في الهجرة غير الشرعية، يحكي عن إهانة الشرطة لهم، وسبها لأمهاتهم، وضربهم وتعذيبهم لمجرد أنهم احتسوا الشراب، ويختتم حديثه بتساؤل: “كيف يُطلب مني أن أحب تونس مع كل تلك الإهانات.. كأننا موتى على قيد الحياة.” بينما يتحدث عامل آخر أكثر نضجاً: “تسألني هل أنا سعيد؟ لا.. أنا لست سعيد بسبب الضغوط النفسية، البطالة هي سبب كل أرقنا.. بدون عمل لا نستطيع أن نبني مستقبلنا. أنا ضحية لهذا البلد. لكن عندما أفكر في الرحيل لا أفكر فيه لا لأنني أكره بلادي، لكن لأنني أكره الأوضاع فيها، أكره أوضاعي أنا فيها.”
طوال الفيلم نرى الحياة بكافة أشكالها التي يعيشها هؤلاء الكادحون، نراهم يتشاجرون، يغضبون لعدم وجود فرصة عمل أو بسبب النصب عليهم، أو بسبب عدم حصولهم على الأجر مقابل العمل، أو لأن أحدهم لم يساند صديقه ويقف إلى جواره في الشهادة ضد مومس، نسمعهم يشتكون ويضجرون، وفي بعض الأوقات يتمنون الموت لأنفسهم ليستريحوا من وجع الحياة، لكنهم لا يستسلمون وسرعان ما يفكرون في حل جديد لمشاكلهم، إنها المقاومة والرغبة في مواصلة الحياة. قد يحرموا من الطعام ساعات طويلة، فوسط هذه الأجواء لا وجود للمياه ولا الطعام ولا السجائر لكن فقط التبن. ومع ذلك وسط كل هذا الحزن والشجن والحرمان يبدأون في الغناء وهم جالسين في الشاحنة وعلى الطرقات. يبحثون عن أي لحظة للمتعة لاقتناصها، كما الصبار، يقول أحدهم: عندما ننتهي من العمل نتناول البيرة ثم نخرج إلى مدرسة “الليسيه” فهناك فتيات كثيرات جميلات.. أو أنتظر الفتاة التي أصاحبها، بصراحة أنتظرها لأن البنات اللائي أعرفهن يعملن في المصانع ومعهن فلوس وهن اللائي يصرفن فأنا لا أمتلك المال. نحن نعيش من أجل هذه المتع الصغيرة. فالجنس والشراب هو ما يحقق لنا المتعة. إنهما دافعنا في الحياة، فهل هناك باعث أو سبب آخر؟
بوعزيزي آخر
تبقى الدقائق العشر الأخيرة من الفيلم ذات خصوصية كبيرة لما بها من شحنة صادمة ومؤلمة جداً، فبعد مشاجرة عنيفة شديدة الصراحة والعتاب القاسي بين الصديقين، يأتي المشهد المذهل لخيري ذلك الشاب الضحوك الساخر طوال الفيلم والذي يهتم بمظهره وشعره، والذي يزين ذراعه بوشم التنين، ويهتم بارتداء الدلاية في عنقه نفاجأ به في هيئة أخرى، الشكل تغير بعد مرور سنة، فاللحية طويلة والوجه يكسوه الحزن والهم وكأنه كبر سنوات عدة لا سنة واحدة، يجلس مهزوم ملتحف بالعباءة الواسعة، بعد قليل عندما يرفعها تصيبنا الغصة ووخز الضمير، إذ نرى آثار الحروق والتشوهات على يديه نتيجة محاولته الانتحار حرقاً في ديسمبر 2011. أن يحرق بوعزيزي نفسه قبل الثورة ليكون وقودها فهو أمر صار مستوعب، لكن أن يحاول هذا الشاب أن ينتحر أربع مرات قبل مرور عام من قيام الثورة فهذا أمر يحتاج أن نتوقف أمامه – ليس فقط في تونس ولكن في كافة بلدان الربيع العربي – وكأن ما فعله خيري في نهاية الفيلم يرد على أقوال آخرين: بن علي هرب ولم يهرب، بن علي لايزال يحكم، فالنظام لم يتغير، لايزال النظام كما هو، والبطالة لم تختفي وإنما تضاعفت، والظلم لايزال يعشش في جنبات الوطن.
رغم كل هذا الوجع وهذه الحقائق المرة لكن الفيلم ليس كئيباً، فهو عمل مملوء بالحياة النابضة بحلوها ومرها، وقد ساهم في هذا توظيف الأغاني بكافة أنواعها التي استخدمها حمزة عوني والتي كان الشابان يرددانها كثيراً بين حين وآخر، والتي جعلتنا نتعاطف معهما كثيراً لأنها كانت انعكاسا لعالمهما، وتعبيرا عن وحدتهما، كانت الأغاني تجسيدا لإحساس المرارة والخيانة والخذلان والظلم والقهر والاضطهاد الذي يعيشانه في بلدهما. لم يستخدم عوني الموسيقى الخالصة، الموسيقى المباشرة تختفي تماما من الشريط السينمائي، تظهر فقط من خلال الأغنيات التي يغنيها بطلا الفيلم الأساسيان. هناك أيضاً موسيقى من نوع آخر، من خلال رنات الموبايل، والأغاني المسجلة عليه، من خلال أصوات الماعز والأغنام، من خلال صفير القطار وصوت عجل العربة الكارو، وصوت آلات التنبيه للسيارات، وموتور الشاحنات وهو يزمجر، من خلال زخات المطر الغزير، وصوت الباعة ينادون على بضاعتهم وسط ضجيج السوق، من خلال نباح الكلاب، وزئير الدراجات البخارية مختلطاً بصراخ الشباب من فوقها في لحظات المرح والترفيه.