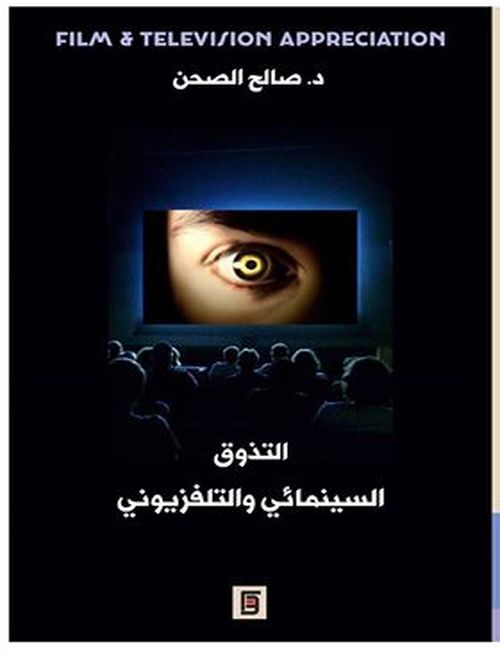تداعيات وذكريات من دفتر السينما الجميلة

(1)
أثار فيلم “سواق الأوتوبيس” منذ عرضه عاصفة من الإعجاب، وفتح الباب واسعا أمام أنضج نماذج ما اصطلح على تسميته بتيار الواقعية الجديدة، ومازلت أراه من أهم وأفضل أفلام السينما المصرية.
اعتبرته أيضا هجائية عنيفة، هى الأنضج والأذكى، لعصر الإنفتاح، جيل الحرب يرد الصفعة ويفضح اللصوص، ليست الحكاية كما قد تظن عن الضرائب التى حجزت على ورشة الاب، ولكنها عن ضريبة الدم التى دفعها جيل ابنه حسن (نور الشريف)، بينما حصد الثمار لصوص الداخل من أمثال عونى (حسن حسنى فى أحد أفضل أدواره) وشركاه، الشاطر حسن كسب معركة الجبهة مع رفاقه، ولكنه خسر معركة الداخل، ابتعد عن والده فافترسه الحيتان، صرخة النهاية هى صرخة جيل بأكمله تم تهميشه، فقنع إما بالسفر أو بالوظيفة البسيطة أو بتذكر وقائع الحرب والشهادة أسفل الأهرامات وسط ظلام تضيئه أنوار شحيحة.
يكتسب موت الأب دلالة تراجيدية هائلة، ولذلك يلغى عاطف الطيب شريط الصوت تماما فى مشهد الوفاة، يكتفى بوجوه مشوهة باستخدام عدسة واسعة، يتجاوز الميلودراما ليترك من خلال الصمت فرصة للتأمل واليقظة، يصنع مسافة بينك وبين المشهد: هذا ما حدث عندما انتشر الجراد البشرى يبيع ويشترى ويكرس قيمه الفاسدة، الورشة نفسها هى الوطن الذى كان، هى كل القيم النبيلة المفقودة، الأب هو الرمز الاشهر عند جيل الخمسينات والستينات كله، حتى علاقتهم بعبد الناصر كانت علاقة أبوية (راجع بعض قصص يوسف إدريس مثلاً)، ما يجعل فيلم “سواق الأوتوبيس” عظيما أن الورشة أصبحت وطنا، وحسن عاد جنديا، والأب صار جدارا يهدمه اللصوص، والحب تحول الى مقايضة، والموت أصبح بعثاً، أصبحنا امام فيلم يذكرنا بقوة بأفلام الواقعية الإيطالية: بساطة الحكاية، وعمق مضمونها ودلالاتها.
أما التجسيد البصرى لهذه المأساة، فهو لا ينفصل عن مضمونها، كاميرا الكبير سعيد شيمى المهتزة والمحمولة لا تنقل فقط نبض الحياة، ولكنها تعبر عن عالم مهتز على وشك السقوط، مشهد الموتوسيكل وهو يسير فوق الرصيف، وتلك الجمال التى تعبر إشارة المرور وسط السيارت، ليست سوى الترجمة البصرية لعالم فوضوى سينتهى بهدم عمود الخيمة.
الكادر الضبابى ليس فقط تعبيرا عن دموع حسن وهو يتذكر طفولته، ولكنه ترجمة لحياة ضبابية اختلت فيها القيم والمفاهيم، كل مشهد تقريبا يمكن أن تكتب عنه صفحات، ولكنها فى قلب المعنى: لقاء شلة القرواانة تحت سفح الهرم: مرثية جيل منتصر/ مهزوم، زاوية الكاميرا المنخفضة والأب يتقدم نحوها عملاقا كتمثال شامخ وهو يسمع تاجر مخدرات عجوز يطلب ابنته للزواج، عزيزة حلمى كوجه مضئ على خلفية سوداء:
ملاك الأسرة وسط الظلام الدامس، زاوية الكاميرا المنخفضة فى نهاية الأوتوبيس الفارغ، فى المقدمة حسن يعرف لأول مرة من أخته بأزمة والده، يضرب فرملة، فيهتز الكادر كله، لم يعد الأوتوبيس وسيلة مواصلات، حوّله الكادر وزاوية التصوير وفراغ المقاعد والفرملة الى نفق تعرض لهزة أرضية، اللقطات من أعلى لاجتماعات الأسرة واشتباكاتها، تبدو مثل عقد أو مثل السبحة، ولكن تأمل قليلا تكتشف أنه عقد منفرط الحبّات، أغنية عبد الحليم “ياقلبى خبى” التى تصلح عنوانا على مأساة حسن وجيله، ثم مشهد النهاية الذى أعتبره من اقوى فينالات الأفلام المصرية.
قال لى المخرج محمد خان المشارك فى القصة، والذى كان سيخرج الفيلم لولا انشغاله بفيلم موعد على العشاء، إن النهاية التى كتبها كانت أيضا تجسد انفجار حسن: ينظر الى التاكسى، يسكب عليه البنزين، ويلقى عليه عودا من الكبريت المشتعل، الحقيقة أن النهاية التى ظهرت أقوى وأفضل، قرأت أن مشهد معركة حسن مع اللص فى الشارع، كان موقعها فى السيناريو فى وسط الفيلم، ولكن نادية شكرى (مونتيرة الفيلم العظيمة ) اقترحت أن يكون المشهد فى الفينالة، لاحظ معى ما يلى: مع نهاية مشهد وفاة الأب الصامت والمشوه، تقتحم شريط الصوت من المشهد القادم صوت صرخة امرأة، نعتقد لأول وهلة أنه صوت إحدى بنات المتوفى.
ونكتشف مع القطع السلس الى داخل الأوتوبيس أنه صوت امرأة اكتشفت سرقة نقودها، دمجت المونتيرة العظيمة المشهدين معا عن طريق شريط الصوت، فاصبح صراخ المرأة التى نُشلت عدودة على الأب،واحتجاجا على موته واصبح ضرب حسن للص وسبابه له ترجمة لأمر لم يفعله مع من قتلوا والده، ,أصبح فعل النشل فى الأوتوبيس مجازا بصريا هائلا لفعل نشل الورشة والوطن من أصحابه، وأصبح الموت واكتشاف السارق بعثا جديدا لحسن، ثم .. تقتحم الصمت ومؤثرات اللكمات نغمة بلادى بلادى بسرعة بطيئة حزينة (موسيقى تصويرية للرائع كمال بكير الذى لم يأخذ جقه ابدا)، بالتزامن مع تحول اللقطة الى الحركة البطيئة، يثبت الكادر على لكمة وسباب هائل كأنه قادم من النفق/ الأوتوبيس، ومن زاوية عدسة واسعة جدا، هذه اللقطة الأخيرة هى التكثيف البصرى الفذ للفيلم بأكمله: إنه لكمة الجيل المهمش ضد اللصوص، لا مهادنة بعد اليوم، ولا صمت، ستدفعون الضريبة كاملة أيها الأوغاد، عاد الشاطر حسن وجيله من جديد، عادوا جنودا فى معركة أصعب بكثير من حرب أكتوبر.Top of Form
ياسلام على الفن العظيم الذى يمنح الواقع معناه، ويعيد تشكيله لانتقاده، و يهدم القبح، ويبنى الجمال.
(2)
عبد الفتاح القصرى أحد المواهب الكبرى فى مجال الكوميديا، هو الذى صنع شخصيته الفنية مستغلا كل شئ: شكله وهيئته ومشيته وووجهه وطريقته فى النطق، ورغم أن هناك من سبقه فى شخصية ابن البلد خفيف الظل والمتعالم مثل محمد عبد القدوس (والد إحسان عبد القدوس والذى اشتهر بشخصية اسمها المعلم قندس)، وفوزى الجزايرلى (المعلم بحبح)، إلا أن القصرى اكتسح الجميع. يرجع رسوخه فى الأداء الى أنه قادم مثل كل معاصريه من المسرح، كان عضوا فى الفرق التى كونها الريحانى عبر تاريخه، انظر كيف يناطح الريحانى باقتدار فى فيلم “سى عمر”، ورغم أن الشخصية التى لعبها قاسية ودموية (المعلم ساطور) ، إلا أن القصرى أضفى عليها خفة دم غير عادية، لو ظهر القصرى فى فيلم صامت لكان ايضا كوميديانا، تكفى مشيته وحركة ذراعيه يمينا ويسارا التى تجعله أقرب الى قارب يتحرك بمجدافين، فى أحد الأفلام كان يقلد حركة الغوريلا، أما العبارات التى كان ينطق بها، فهى من إبداع مجموعة من أهم كتاب المشاهد الكوميدية من بديع خيرى وتلميذه أبو السعود الإبيارى الى الكبير على الزرقانى (مؤلف فيلم الأستاذة فاطمة) والمخرج عباس كامل (مؤلف فيلم ابن حميدو).
لم تمت شخصية المعلّم المتعالم بعد وفاة عبد الفتاح القصرى، فقد أعاد الراحل محمد رضا تشكيلها حتى استهلكها تماما، ثم حاول على الشريف فى أدوار كوميدية قليلة أن يبعثها، واليوم يحاول ضيائى الميرغنى تقديمها بصورة فجة وثقيلة، ولكن ظل القصرى دوما ماركة مسجلة ومتفردة، فى أحد أفلامه كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة أمام المعازيم الأجانب، ترجمة فورية معتبرة، فعندما يقول لصديقه :” your night is eggيا خواجة، فهو يقصد بالتأكيد “ليلتك بيضا يا خواجة”، وعندما يسأل :did you write your book on your wife؟ فهو يتساءل عما إذا كان الخواجة قد كتب كتابه على زوجته، القصرى شخصية ممتنعة التقليد، مدرسة هو طالبها الوحيد، تركيبة تمزج بين عروض الفرجة الشعبية مثل الأراجوز والمحبظاتى المرتجل، إفيهاته مصرية فهلوية ، ملك الحداقة الذى يعيش الحياة كلاما وتريقة، وعندما يقرّظ خطيب ابنته، يسبغ عليه من الصفات ما لم يحققه هو، فيقول : “الباز افندى ده قارى وفاهم ومستوعب الأشياء .. ده ساقط توجيهية”. المواهب الإستثنائية لا تنطبق عليها القواعد، ولكن يجب أن تدرس كل شخصية كحالة منفردة فى فن الأداء، وبالذات نجوم الكوميديا.
(3)
كان فيلم “المنزل رقم 13” إعلانا عن مولد مخرج كبير هو كمال الشيخ، المونتير المتمكن الذى عمل كثيرا مع أنور وجدى (من أشهر أعمالهما المشتركة فيلم غزل البنات)، قدّم فى عمله الأول نموذجا جيدا جدا من أفلام الجريمة محكمة الصنع التى تستخدم إمكانيات الأبيض والأسود.
الفيلم بدأت فكرته بخبر فى سطور قليلة نشر فى جريدة المصرى حول جريمة أرتكبها شخص فى دولة أجنبية تحت تأثير التنويم المغناطيسى، تستطيع أن تقول أن فيلم التشويق المصرى أيضاً ولد مع هذا الفيلم الذى يبدأ مباشرة بالجريمة، والذى يتحدى مشاهده فيكشف له عن حيلة الطبيب فى استغلال مريضه فى وقت مبكر جدا، ومع ذلك لا تستطيع أن تغادر مقعدك حتى النهاية. الصراع فى الفيلم ليس علنيا فقط، ولكنه بالأساس صراع داخل بطل الفيلم الذى يحاول أن يسترد إرادته المفقودة، الإرادة هى مناط الثواب والعقاب، لولاها لأصبح الإنسان مجرد آلة يحركها الأخرون، هذا هو المعنى الأعمق للحكاية، التشويق وإيقاع الفيلم يبدأ من السيناريو، لابد أن يبنى كل مشهد بدقة فى وحدة واحدة مع المشهد السابق والمشهد التالى.
كمال الشيخ له أسلوب منضبط يذكرك بكلاسيكيات الأفلام الأمريكية، لا توجد أى ثرثرة أو إسهاب، ولا يوجد كادر زائد أو جملة حوار أطول ممايجب، الإحساس على قدر الجملة، توظيفه للموسيقى رائع، لا يوجد استعراض من أى نوع، متأثر جدا بالمدرسة التعبيرية فى الإضاءة، الفيلم الذى جعله يحب السينما ليس من أفلام هيتشكوك كما يتوقع البعض، ولكنه فيلم “امرأة فى النافذة” للمخرج الألمانى التعبيرى الكبير فريتز لانج.
سأشير فقط الى نموذجين من التميز الإبداعى فى الفيلم ، الأول هو الطريقة الفريدة التى قدم من خلالها مشهد الفلاش باك بتغيير الإضاءة فقط، ودون أى قطع، كان ذلك فى لقاء فاتن مع فردوس محمد فى المنزل، يفترض أن الإضاءة نهار داخلى، تقترب الكاميرا من وجه فردوس وهى تتحدث عن عودة ابنها ذلك المساء الى المنزل، تتحول الإضاءة الى ليل داخلى، تسمع صوت عودة ابنها، تترك فردوس السرير، لا وجود لفاتن، انتقلنا الى الماضى فى لقطة واحدة فقط بتغيير الإضاءة، على كثرة ما شاهدت من أفلام، لم أجد أبداً مثل هذا الإنتقال العبقرى فى الزمان، من الحاضر الى الماضى.
أما المشهد الثانى فهو مشهد الفرح الذى يتكرر مرتين، فى المرة الأولى ينتهى بالقبض على العريس بتهمة القتل، وفى المشهد الثانى يعود الى عروسه بعد ظهور براءته، استخدم كمال الشيخ فى المشهدين نفس حركة الكاميرا، فبدا كما لو أننا أمام مشهد واحد متصل، قطعته جملة اعتراضية هى عملية القبض على البطل، مجرد كابوس بين قوسين من الفرحة. كمال الشيخ مخرج كبير، يمكن أن تقارنه بأى مخرج عالمى، بل إنه فى رأيى أحد أساتذة النوع الكبار(لفيلم التشويق) فى تاريح السينما.
(4)
يمكن أن تعتبر فيلم “العار” نموذجا جيدا لما نطلق عليه الفيلم التجارى جيد الصنع، ولولا نهاية وعظية مباشرة، لاستحق مكانة أكبر وأهم، كثيرون لم يلاحظوا خطورة أن تطرح سقوط أفراد أسرة، وانهيار قيم بعض أفرادها (المتعلم مثل الجاهل) فى عام 1982 سنة عرض الفيلم، لاتنس أيضا أن السقوط سيشمل طبيبا ووكيلا للنيابة، بل إن ممثل الدفاع عن المجتمع هو الذى سيقوم بتبرير السقوط فى مشهد شهير مع شقيقه الطبيب، يقوم الفيلم ثانيا بإسقاط صورة الأب المثالى، وينسفها أمام أبنائه، ومرة أخرى يمثل الأب وسقوطه معنى أساسيا فى فكرة إنهيار الأسرة فى زمن الإنفتاح، الذى جعل العار “فى فقر الفلوس، وليس فى فقر النفوس”.
نحن إذن أمام تنويعة أكثر شعبية وبساطة على نفس النغمة الإنتقادية لتيار مخرجى الواقعية الجديدة، نجح محمود ابو زيد ليس فقط فى رسم شخصياته، ولكن أيضا فى بناء الصراع معتمدا على مأزق الإختيار بين المال والشرف، بسبب إحكام البناء، فإنه حتى لو نجحت عملية بيع المخدرات، فإن ذلك لم يكن سيغير شيئا من فكرة سقوط الإخوة الثلاثة، بل ربما كان نجاح الصفقة، وعودة كل واحد الى عمله الأصلى، يدعم أكثر المعنى الخطير، السياسى والإجتماعى، ولكن الفيلم شاء إغلاق أقواسه، بعد أن وصلت فكرته.
كل مشاهد الثلاثى نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمى المشتركة جيدة، بل إن هناك مشهداً أعتبره من أفضل مشاهد الحركة المزدوجة للكاميرا والممثل معا فى تاريخ السينما المصرية، أعنى بذلك مشهد المواجهة بين الأبطال الثلاثة فى المنزل، حيث يتغير التكوين وحجم اللقطة خمس أوست مرات متتالية باستخدام الكاميرا المحمولة وحركة الممثلين الثلاثة (مدير التصوير سعيد شيمى)، وفى كل مرة تترجم حركة الكاميرا والممثلين معنى الحوار، ومعايير القوى بين الأطراف الثلاثة، والمشهد بأكمله لقطة واحدة مستمرة مليئة بالحركة المتوترة، وهو أمر شديد الصعوبة، من اللقطات المعبرة ايضا هبوط نور وخلفه حسين فهمى من سلم دكان العطارة إرهاصا ببداية السقوط. بالمناسبة، كلوزات وجوه الأبطال فى الماء مأخوذة فى حمام سباحة صغير، وقد تم دمجها ببراعة فى المونتاج مع مشاهد البحر، وكان لموسيقى حسن أبو السعود دور كبير فى تقديم معادل مؤثر للصراع الشرس المتواصل من أول الفيلم الى آخره.
(5)
يبدو فيلم “ريا وسكينة” اليوم كعمل بوليسى خفيف ومسلّ لا علاقة له بالقصة الأصلية التى تجد تفاصيلها الحقيقية فى المسلسل الماخوذ عن كتاب صلاحعيسى المأخوذ بدوره من ملفات القضية مباشرة، ولكن الفيلم يتفوق فى عناصر ونقاط اساسية حفظت له أن يكون من ايقونات السينما المصري.
إنه أولا محاولة رائدة لتقديم معالجة سينمائية لقصة حقيقية عن جرائم حدثت بالفعل، ثانيا هناك تميز فى عناصر الإخراج (صلاح أبو سيف) والمونتاج (إميل بحرى) والديكور ( الكبير ولىّ الدين سامح)، ثالثا هناك الأداء الإستثنائى من نجمة ابراهيم (ريا) وزوزو الحكيم (سكينة) الى درجة أن صورتهما طغت على صور الشخصيتين الأصليتين، وظلا أبرز من لعب الدورين على كثرة معالجات القصة ( قدّمها مثلا نجيب الريحانى فى مسرحية تراجيدية، وهناك طبعا مسرحية شادية وسهير البابلى، وقُدمت كحلقات إذاعية، وظهرت الشخصيتان فى فيلم إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، وقدمت نجمة ابراهيم القصة فى مسرحية فى نهاية الخمسينات تحمل أيضا اسم ريا وسكينة)، وهناك رابعا الحوار الذى كتبه السيد بدير باللهجة الإسكندرانية، وقد اصبح هذا الحواراليوم من ايقونات السينما المصرية، أما السيد بدير نفسه فهو لوحده مؤسسة فنية تستحق كتابا كاملا، ولدينا أخيراً أحد أهم مشاهد التصوير والمونتاج (وحيد فريد وإميل بحرى) ، وهو مشهد قتل الراقصة زينات علوى، وأعتقد أنه يدرّس فى معهد السينما كنموذج للبناء المونتاجى المتصاعد، يحمل المشهد بصمات التأثر بالمدرسة التعبيرية الألمانية، وقد لجأ وحيد فريد الى استخدام قصعة عمال البناء (وعاء مُقعّر القاعدة)، لإعطاء تأثير اهتزاز الكاميرا ترجمة لترنح الراقصة المخمورة: جلس المصور على القصعة حاملا الكاميرا بيده، وقام مساعده بتحريكه هو والكاميرا يمينا ويسارا، بحركات محسوبة، فأعطى التأثير المطلوب، بعد محاولات سابقة فاشلة باستخدام وسائل أخرى. كانوا جيلاً عظيماً من الموهوبين الكبار.
(6)
فيلم “حياة أو موت” هو بالتأكيد أحد أفضل أفلام السينما المصرية عبر تاريخها، ليس فقط بسبب بنائه البصرى والمونتاجى والمنطقى المحكم، ولكن أيضا بسبب مغزاه الإنسانى، لاحظوا أن البناء بأكمله قائم على أمرين هامين : تعاون عشرات الأشخاص لأنقاذ شخص واحد فقط (عماد حمدى)، بعضهم يعرفه، ومعظمهم لا يعرفوه على الإطلاق، المعنى العظيم هنا هو أن أى إنسان يستحق أن تنقذه، وكل إنسان جدير بالحياة، أما الأمر الثانى فهو أن المحرّك الوحيد للأحداث هو يقظة ضمير الطبيب (حسين رياض) الذى قد يؤدى بلاغه الى تضرره مهنيا، ولكنه اختار الأصعب، المعنى هنا هو أنه بدون هذا الضمير الفردى، ما كان يمكن أن يكون هناك فيلم أو حياة، من هذه الزاوية الواسعة فإن “حياة أو موت” هو قصيدة حب للإنسان من حيث هو إنسان وكفى، وهو يتحدث بنفس الدرجة عن حياة الضمير وليس موته .
كلما شاهدت الفيلم تذكرت مقالا جميلا كتبته الصحفية المصرية فريدة الشوباشى منذ سنوات، حكت أن ابنها الوحيد تعرض لأزمة صحية وهما فى فرنسا، فنقلته الى المستشفى، مثل أى أم قالت للطبيب : “اعتنى به فهو ابنى الوحيد”، رد الطبيب مستنكرا: “كل إنسان يا سيدتى هو نسخة وحيدة لا تتكرر،وليس ابنك وحده”..
“حياة أو موت” قال نفس المعنى الرائع ببراعة فنية ومنذ عام 1954 . الفيلم من إنتاج آسيا، وكتب قصته واشترك فى السيناريو مع على الزرقانى وأخرجه كمال الشيخ، أحد كبار مخرجى المحروسة، وصاحب شارع أفلام التشويق، والمونتاج لزوجته المونتيرة المتمكنة “أميرة فايد”، وطبعا تحت إشرافه لأنه مونتير كبير، كما سجل الفيلم إنطلاقا غير مسبوق لتسجيل الحياة فى شوارع مصر ( المصور الكبير أحمد خورشيد) ، وذلك قبل سنوات طويلة من إنجاز أساتذة التصوير بالكاميرا المحمولة على الكتف مثل سعيد شيمى ومحمود عبد السميع، يستخدم الفيلم طريقة الإنقاذ فى آخر لحظة التى اشتهر بها المخرج الشهير ديفيد جريفيث، ولكن أرجو أن تلاحظ هنا أن كل مشاهد الفيلم تتجمع فى بؤرة لقطة الإنقاذ الأخيرة، ومع ذلك فإنها تحبس الأنفاس لإحكام بناء السيناريو، التشويق إذن يبدأ من الورق، ملاحظة أخيرة: تكررت نفس الحادثة على أرض الواقع فى التسعينات، طبيب كتب روشتة دواء يمكن أن يقتل مريضا بالسكر، لجأ مباشرة الى التليفزيون المصرى، لحسن الحظ كانت مصر كلها أمام الشاشة بسبب مباريات كاس العالم، أذيع تحذير تنبيه المواطن من خطورة تناول الدواء مثل الفيلم بالضبط، ولكن عن طريق التليفزيون، طرق الجيران الباب عليه، تم إنقاذه، كان يسكن فى منطقة الطوابق بفيصل . صدقونى، الفن إذا كان متقنا وعظيما فإن الواقع هو الذى يقلّده، وليس العكس أبداً.