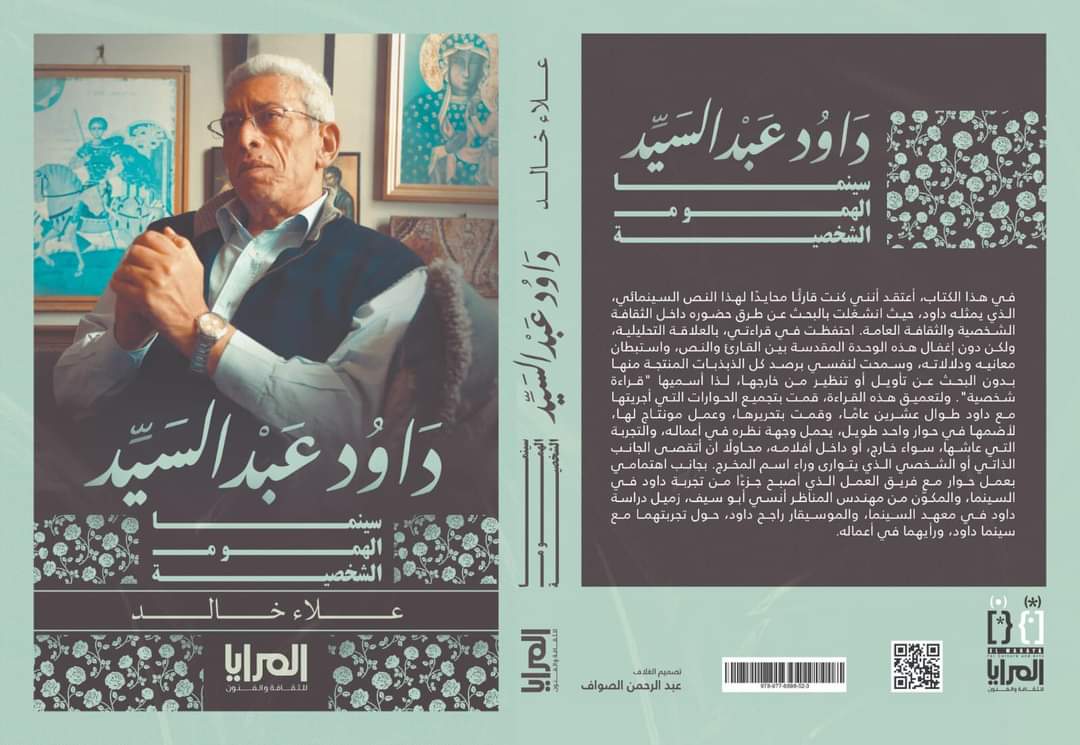“اليهود والسينما فى مصر والعالم العربى”: مشاكل المنهج المزمنة!

القارئ لكتب الناقد والباحث الجاد والمحترم أحمد رأفت بهجت يتنازعه انطباعان أعتقد أنهما صحيحان: الأول إيجابى هو أنك أمام باحث شديد الإخلاص والدأب، لا يتردد فى بذل أكبر جهد فى سبيل جمع مادته، الأفلام بالنسبة له ليست مجرد صور وحكايات، ولكنها مستودع لأفكار واضحة وخفية، وتحمل رسائل تستحق التحليل والتأمل.
أما الإنطباع الثانى فهو سلبى تماماً لوجود مشكلة حقيقية فى منهج البحث والتحليل، بالذات فيما يتعلق بتتبع دور اليهود فى السينما المصرية والعربية، وبينما يصدق التحليل على أفلام محددة، فإن يقوده أحياناً الى نتائج متعسفة وغريبة، بل إن حكاية البدء بتصنيف صاحب العمل وفقاّ لديانته اليهودية، وليس وفقاً لموقفه السياسى من الصهيونية وإسرائيل، يقودنا مباشرة الى مشكلة معقدة شديدة الخطورة.
لا يمكن أبداً أن يكون كل فيلم أنتجه شخص يهودى، أو اشترك فى بطولته ممثل يهودى، عملاً خبيثاً وشريراً يضع السم فى العسل، ومتهما تلقائيا بأن له أهدافاً صهيونية إمبريالية، حتى يثبت العكس.
وليس صحيحاً بأن كل يهودى صهيونى بالسليقة، وإن تخفىّ واستتر وراء أقنعة وجدران، وليس معقولاً أن تكون الكوزموبوليتانية مصيبة أو نقيصة أو نوعاً من “العنصرية الجديدة”!
كان ذلك خلاصة رأيى أيضا بعد قراءة كتاب “اليهود والسينما فى مصر والعالم العربى” للناقد أحمد رأفت بهجت، والصادر مؤخراً عن سلسلة آفاق السينما التى تصدر عن هيئة قصور الثقافة. الكتاب فيه جهد عظيم، ويقدم حشداً من الدراسات عن أفلام وشخصيات كثيرة، ويمكن اعتباره طبعة ثانية من كتاب الناقد السابق عن “اليهود والسينما فى مصر” الذى صدر فى 2005، ولكنه أضاف الى الكتاب الجديد، قراءاته وتحليله لأفلام جديدة مصرية هامة من الفيلم الوثائقى “سلطة بلدى” لنادية كامل الى الأفلام الروائية الطويلة مثل “السفارة فى العمارة” لعمرو عرفة و “ورقة شفرة” لأمير رمسيس و”هليوبوليس” لأحمد عبد الله و”رسائل البحر” لداوود عبد السيد و”إسكندرية- نيويورك” ليوسف شاهين، متتبعا الشخصيات والموضوعات التى تدور حول الشأن اليهودى فى تلك الأفلام، كما أضاف فصولا عن اليهود والسينما فى العراق وفلسطين ودول المغرب العربى .
ليس هناك خلاف على وجود منتجين وممثلين وموزعين يهود ساندوا الصهيونية، الخلاف الكبير سواء فى هذا الكتاب الأشمل، أو فى الكتاب الأسبق عن اليهود فى السينما المصرية، على التعميم الصارم لهذا المنهج مما يؤدى فى النهاية الى نتائج غريبة ومبتسرة بل ومضحكة، القول بأن ” كل يهودى صهيونى وشرير حتى يثبت العكس”، يعادل بالضبط ما يقوله الغرب أحيانا بنفس المنهج بأن ” كل مسلم أو عربى إرهابى حتى يثبت العكس”، أما المدن الكوزموبوليتانية التى تتعايش فيها القوميات والهويات الدينية والثقافية، فهى أيضا حقيقة تاريخية، أمريكا نفسها هى النموذج الأكبر لهذه الفكرة التى لم توجد فى مدن مصر فقط، ولكن فى مدن كثيرة من دول العالم.
الفكرة الكوزموبوليتانية التى يتوجس منها مؤلف الكتاب بوضوح، تسبق ظهور الأديان السماوية، ويمكن أن تجدها مثلاً فى أفكار الإسكندر الموروثة عن أستاذه أرسطو، وتحليل الأفلام بالتركيز على هوية صانعيها الدينية فحسب، يمكن أن يؤدى الى تعسف فى التفسير، أو الى الوصول الى النتيجة قبل التحليل أصلاً، وكأن المطلوب إثبات ما هو معروف من قبل بالبرهان النظرى، كما فى مسائل الهندسة، وليس الوصول واكتشاف النتائج، عبر سلسلة خطوات وتفاصيل موضوعية.
وإذا كان معنى تلك الدراسات الضخمة هو كشف شخصيات أو أفلام تحمل أفكاراً عنصرية صهيونية، فلماذا يختار المؤلف عنواناً يصنف الشخص على أساس الديانة، وليس الموقف السياسى؟ وكيف انمحت الفروق بين اليهودية كديانة سماوية، وبين الصهيونية كعقيدة سياسية تستغل الدين لأهداف استعمارية توسيعية وعنصرية؟ وكيف يمكن أن ننتقد الغرب على نظرته النمطية الأحادية الشمولية تجاه صورة العربى والمسلم (والتى انتقدها أحمد رأفت بهجت بشدة فى كتاب شهير عن الشخصية العربية فى السينما العالمية)، بينما يستخدم هو نفس المنهج التعميمى الغريب تجاه كل يهودى؟ يكفى أن يعرف الناقد الدءوب أن هناك يهودياً فى العمل حتى يقوم باستقصاء بوليسى نقدى وتفصيلى، لمجرد إثبات أن الفيلم الفلانى قد ضحك علينا، وأنه خدعنا، وأن أى قيمة إنسانية عامة فيه ليست إلا ستاراً لتمرير أفكار مسمومة، يمكن أن تدمر أجيالاً بأكملها !
نوايا وحقائق
لاشك عندى فى نوايا الناقد الدءوب، بل إننى أتفهم قلقة من الإختراق “الصهيونى” لوسائل الإعلام، ولصناعة الترفيه، وأتفهم جداً قلقه على أجيال جديدة لا تقرأ كثيراً عن تاريخها، وأوافق بالطبع على وجود نماذج لأفلام غير بريئة سياسياً هنا أو هناك، ومن كل الإتجاهات، وليس من أنصار الصهيونية فقط، ولكن كل ذلك لا يبرر التعميم، ولا يلغى حقيقة أن الخلط بين العقيدة الدينية، والعقيدة السياسية أمر كارثى وشديد الخطورة، وأكثر من دفع، وسيدفع ثمنه هم العرب والمسلمون.
هناك يهود أكثر رفضاً لإسرائيل والصهيونية من أى عربى ومسلم، وهناك مسلمون خدموا الفكرة الصهيوينة جهلاً أو لمطامع سياسية أكثر من أى صهيونى، والتعامل مع الأفلام بمنطق الشك والريبة، يمكنه ببساطة أن يفتح الباب لإعادة النظر فى أى فيلم صنعه الإنسان، بل وفى أى عمل فنى قديم أو معاصر.

أستطيع بنفس هذا المنهج الدينو/ فنى أن أشكك فى نوايا كل الذين صنعوا لوحاتهم العظيمة استناداً الى التوراة وقصصها، ويمكننى أن أكتب مقالاً طويلاً فى تحليل الأبعاد الخفية، والنوايا الخبيثة المستترة، فى تمثالى داوود وموسى لمايكل أنجلو، إنه مع الأسف نفس المنهج الذى جعل عرب 1948 منبوذين من الطرفين: هم بالنسبة للعرب خونة يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهم بالنسبة للصهاينة خونة وطابور خامس، يمكن أن ينقلبوا على الدولة الصهيونية فى أى وقت.
أصعب وأهم ما فى مناهج البجث والتحليل عملية تحديد المفاهيم، ومشكلة كتاب “اليهود والسينما فى مصر والعالم العربى” فى انمحاء الفواصل بين الدينى والسياسى والفنى، اليهودى صهيونى إلا من رحم ربى، ومؤسس الفيلم التجارى المصرى توجو مزراحى خبيث ومغرض ويستحق المراجعة، ولا تفرقة على الإطلاق بين أن تنعكس فى أفلامه مظاهر تربيته اليهودية بشكل طبيعى، وبين أن تكون تلك المظاهر مقصودة لأهداف صهيونية!
ليس غريباً أن ينتهى هذا المنهج الضيق بمؤلف الكتاب الى تأييد مقولة جياترى تشاكرافورتى حول أن “الكوزموبويلتانية (هكذا) أصبحت هى العنصرية الجديدة” !!!، وكأن الفكرة، وهذا الحلم الإنسانى القديم، الذى سبق الديانة اليهودية بالتأكيد، ليس إلا حصان طروادة، الذى تركبه إسرائيل، وكأننا دوماً فى موقف الضعيف المخدوع، الذى لايمتلك ثقافة عظيمة قديمة وحديثة.
السياسى والإنسانى
أومن أن السياسة وصراعاتها أفسدت أشياء كثيرة فى تاريخ الإنسان، ولكنها هى أيضاً التى صنعت الدولة الحديثة التى تستوعب القوميات والأديان، ولا يمكن أن تكون النظرة الإنسانية فى فيلم من الأفلام مدعاة للإنتقاص منه، وجود أخطاء تاريخية مثلاً فى فيلم وثائقى طويل وهام ومؤثر مثل “الجوستو” حول دور اليهود فى الموسيقى الشعبية الجزائرية، لا يجعله بقدرة قادر فيلماً مريباً وخبيثاً ومنحازاً، يكفى الفيلم مغزاه الإنسانى العام، والتقاطه لتلك المشاعر التى يستحيل ألا يتأثر بها المتفرج، أما الأشياء التى تحتمل الجدل فهى مفتوحة للجدل، بل إن أحمد رأفت بهجت يشكو فى مقدمة كتابه أيضاً من ندرة المراجع، وضبابية المعلومات حول موضوعه، فكيف يكون منهجه الشك والشكوى، بينما يفسر الخطأ عند الآخر بأنه سوء نية؟!
فى دراسته عن فيلم “إسكندرية- نيويورك” نموذج آخر على هذه النظرة الإيدلوجية الصارمة التى تسئ فهم ما هو إنسانى، وتحوله الى رؤية سياسية مغرضة، هل من المطلوب وفقاً لهذه الرؤية أن يهاجم يوسف شاهين مدير مهرجان نيويورك الذى عرض أفلامه لمجرد أنه يهودى؟! وهل من المطلوب ألا يقدم شاهين شخصية يهودية، سواء من ماضيه أو حاضره رغم أنه نشأ فى مجتمع كوزموبوليتانى هو الإسكندرية (مع الإعتذار بالطبع لكل من يرى فى كلمة كوزموبوليتانى أمرأ خادشاً للحياء)؟ وبدلا من أن يُفهم حوار يحيى/ معادل يوسف شاهين الدرامى مع صحفى يهودي فى أمريكا على النحو الصحيح، فإنه يُفسر فى الكتاب بما يخدم منهج الشك فى النوايا.
وبينما يمكن اعتبار فيلم “رسائل البحر” لداوود عبد السيد نوستالجيا لكل ما هو أصيل وحقيقى، لا يلفت نظر أحمد رأفت بهجت سوى أن صاحب المنزل القديم فى الإسكندرية يهودى الديانة، وهو أمر كاف تماماً، وفقا لمنهج بهجت، لكى يعاد تفسير كل شئ، وبينما يقدم فيلم “هليوبوليس” مرثية لمصر الجديدة ومعمارها، ليرثى أيضا مصر القديمة المتسامحة، يتوقف بهجت طويلا عند ديانة السيدة العجوز (عايدة عبد العزيز) اليهودية، وكأنه يغير من الأمر شيئاً بالنسبة لمغزى الفيلم، أن تكون يهودية أو أرمنية أو فرنسية أو إيطالية أو حتى مسيحية مصرية مغتربة عن وطنها الذى عرفته.
أستطيع أن أقدم لك عشرات الأمثلة على خطأ النتائج التى يقود إليها خطأ منهج يصنف المبدعين وفقا لديانتهم بصورة أقرب الى “الباترون” الجاهز والنمطى، والعجيب أن مؤلف الكتاب مر مرورا عابرا على الفيلم الهام “عن يهود مصر” الذى يفصل بوضوح بين اليهودية والصهيونية، وإن كنت أثق أن تطبيق “الباترون” سيؤدى الى نتائج عجيبة، وربما يصل الأمر الى اتهام أمير رمسيس بالدعاية لإسرائيل والصهيونية والإمبريالية العالمية.
أعود فى النهاية الى التأكيد على أننى أحترم كثيراً الجهد والجدية فى كل كتب أحمد رأفت بهجت بلا استئناء، بل لولا هذا الجهد العظيم ما كان الحزن الشديد على مشكلات المنهج الواضحة، ما هكذا أبداُ يمكن الإنتصار للقضايا السياسية، ولا يمكن أن ننتقد منهجاً يستخدمه الغرب والصهاينة ضدنا، ثم نقوم نحن باستخدامه ضد كل ما هو يهودى، يا سيدى الناقد المحترم، إننا ضد إسرائيل والصهيونية لأنها بالتحديد صنّفّت الإنسان على أساس الديانة، ولآنها اعتبرت أن الدين وسيلة لطرد أصحاب الأرض، حتى لو لم نكن عرباً لكان يجب أن نعارض الفكرة العنصرية الصهيونية، احتراما لإنسانيتنا قبل كل شئ.
وبنفس المنطق والمعيار، فإننا ضد هذا التنميط ضد أى صاحب ديانة مهما كانت، ونحن مع كل من ينتصر للإنسان فى كل زمان ومكان.