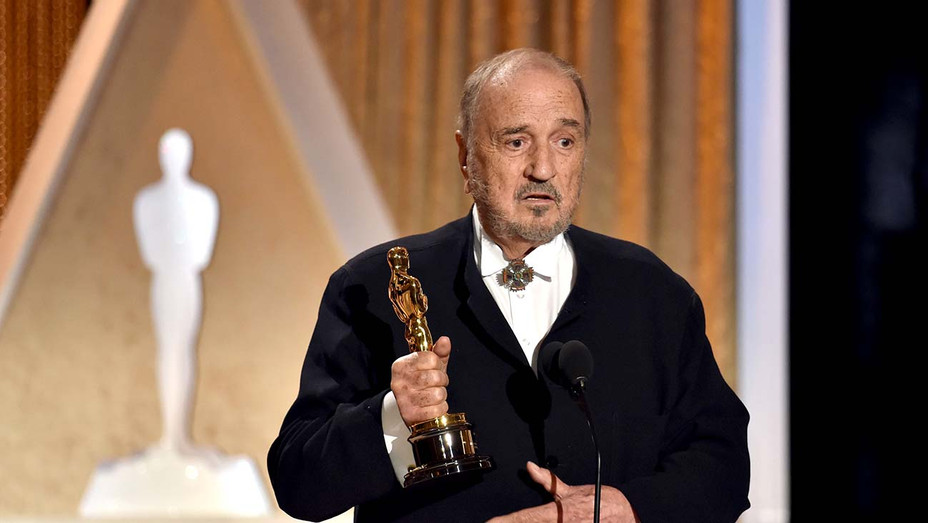أفلام محمد القليوبي.. أسئلة كبرى عن الهوية والدين والإنسان

مازن حلمي- مصر
يمتلك المخرج الراحل “محمد كامل القليوبي” لغة سينمائية تخصه، ومشروعًا بصريًا مغايرًا على الرغم من قلة أعماله، خمسة أفلام روائية طويلة وفيلمان قصيران، بالإضافة إلى مشروعه التسجيلي، (محمد بيومي، وقائع الزمن الضائع) الذى يكشف عن الرائد الحقيقي للسينما المصرية المخرج “محمد بيومي” بفيلمه (برسوم يبحث عن وظيفة) عام 1923، ويصحح المغالطة التاريخية عن الريادة السينمائية في مصر، ليصير أحد هموم القليوبي التنقيب في الذاكرة المصرية، والأرشفة وحفظ التراث من الاندثار.
القليوبي حاصل على دكتوراه من معهد السينما الروسى (فجيك) عن موضوع “الثقافة القومية، وسؤال الهوية في السينما المصرية”. إلى جانب تدريسه فى معهد السينما له إسهامات فى التأليف السينمائى. كان مثقفًا عضويًا يؤمن بقضايا وطنه، ويحارب في سبيلها بالكلمة والصورة.

تتسم سينما القليوبى بوجود خطين دراميين أحدهما داخلي إنساني، والآخر خارجي سياسي، فالحكاية لديه لها غطاء سياسى. في فيلم “ثلاثة على الطريق” تجرى الأحداث أثناء الفتنة الطائفة فى أوائل التسعينات. وفي فيلم ” البحر بيضحك ليه” تحضر حرب البوسنة والهرسك. وأحيانًا يأخذ هذا الخط الخارجى شكل التعليق الموجه المباشر، وأحيانًا أخرى يتشابك فى العقدة الدرامية ويكون عاملًا في تحريك الأحداث، أما فيلم “أحلام مسروقة” فيتناول ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني، البطل طبيب قُتل ابنه في حادث إرهابي، عليه أن يختار بين أن يعالج منفذ الجريمة، أو يقتله.
يؤمن القليوبى بقوة دور الفن السينمائي كأداة لشحن الجماهير، ورفع الوعي، وبذر التمرد والثورة في نفوس المتفرجين، وتحليل الظواهر والبحث عن جذور المشكلات، فأعمال القليوبي تحمل أسئلة كبرى عن الهوية، والحرية، والدين، والإنسان. كما يحضر الوثائقى إلى جانب الروائى في السرد وينصهران في بوتقة واحدة، فلديه حس الأرشفة والتأريخ خوفًا من ضياع التراث، وحفاظًا على الذاكرة السينمائية.
يمكن أيضًا أن نصف الدراما لديه بالدراما النفسية، فجميع شخصياته تمر بمأزق يسبب لها صراعاً داخليًا عليها أن تواجهه، نرى ذلك بوضوح في فيلم “أحلام مسروقة” فهو يعتبر دراما نفسية خالصة. يتخذ الشكل التقليدي في السرد، لا يجازف بمغامرة التجريب؛ حتى لا يفقد جمهورًا، يصل إلى حد مغازلته في فيلم كوميدي سياسي هو “اتفرج يا سلام”.
هذه الخصائص والسمات الأسلوبية نستوفيها بالتفصيل، والشرح في فيلمه الأخير (خريف آدم)، إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 2002، سيناريو وحوار “علاء عزام”، مدير التصوير “رمسيس مرزوق”، موسيقى تصويرية “راجح داوود”. وقد حصل الفيلم على جائزة أحسن فيلم من مهرجان القاهرة السينمائي، وتم ترشيحه حينها لتمثيل مصر فى مسابقة الأوسكار العالمية.
الواقعي والأسطوري
الفيلم مأخوذ عن قصة (ابن موت) للروائي “محمد البساطي”، وقصص أخرى فرعية تتضافر مع الخط الدرامي الرئيسي، بُلورت لتنتج عملًا سينمائيًا ملحميًا.
تدور القصة عن مقتل “فارس بن آدم” في ليلة عرسه على يد عائلة خاطر، وانتظار الأب “آدم” عشرين عامًا حتى يصير “صبري” عريسًا لكي يأخذ ثأره؛ كي تكون العين بالعين. يناقش الفيلم فى ظاهره قضية الثأر في الصعيد المصري، وتَحكُّم الموروث الشعبي في عادات تلك المنطقة، لكن بنظرة متأنية نراه فيلمًا ذا بُعد إنساني وفلسفي وجمالي، يستلهم حادثة القتل الأولى في تاريخ البشرية، قتل “قابيل” لأخيه “هابيل” بمعالجة عصرية، وكيفية تعامل أبوهما “آدم” مع الجريمة. هل سيُقْدِم على القتل انتقامًا لابنه، ليكون العنف قانونًا للتعامل مع الآخر، أم يبسط يده بالسلام مؤمنًا بالحب طريقا للتعايش بين البشر؟ بهذه الفاجعة يأخذ الفيلم الشكل الميلودرامي، فالأب المكلوم كُتب عليه القتل وفق قدرية ما كأحد أبطال المآسي الإغريقية، مع حدوث تحولات فى الشخصية عبر توالى السنين وصولاً إلى حالة التطهير. إلى جانب واقعية أشبة بالواقعية السحرية مما يعطى عدة مستويات للقراءة؛ لثراء عالم الفيلم السينمائي.
السينما كأداة وعى
ينقسم الفيلم إلى ثلاثة فصول: مقتل “فارس” واختيار من سيقع عليه الثأر من عائلة “خاطر”، ثم حكاية “شداد” وزاوجه من “رقية” إضاءة على شخصية “صبري”، وذلك يتماس مع خط سياسي خارجي له ما يبرره دراميًا، ذهاب أبناء القرية إلى الحرب، لإضفاء نوعٍ من الواقعية على القرية، وربطها بما يحدث بالعالم.
مشهدا البداية والنهاية يمثلان قوسين نضع بينهما الموت كقدر ولعنة واقعة على القرية لا فكاك منها.
يرصد المخرج أثر الخرافة وسيطرتها على حياة الشخوص، “آدم” الذي يحيا منتظرًا اللحظة المناسبة للانتقام، “صبري” الذي يلاحقه الموت منذ مولده، و”عباس” أحد أفراد عائلة خاطر عاش أعزبا كي لا يكون الموت مصيره، يعبر عن ذلك بصريًا مشهد الأطفال الذين يلعبون بين المقابر، فالموت وحش وهم واقعون لا محالة بين فكيه. كما نرى “آدم” في مشهد بديع أعلى الكادر يعزق الأرض وفى الأسفل المقابر، ما يزرعه “آدم” يحصده الموت. هذه البلاغة البصرية وإيحائية الصورة تنير وعى المتفرج، وتحرضه على الخلاص من أسر الخرافات والموروثات القديمة التي تُقيِّد حياته وتحولها إلى جحيم.

يتم هدم السلطة الاجتماعية، والسياسية، وفضح أساليب تدميرها لحياة الفرد والشعوب عبر وسيط السينما باعتبارها وسيلة للتثقيف والتوعية، وليست للتسلية والانحراف كما ورد على لسان أصدقاء “صبري” الممثل “أحمد عزمي”. يعارض المخرج الوعي الشعبي ويشكل مفاهيمه من خلال أداة أكثر نعومة ونفاذًا من الأسلحة وهي السينمائي.
هجاء سياسي بصري
يحمل الفيلم إدانة كاملة للعهد الناصري، ومحاكمة تلك المرحلة من تاريخنا عبر ثلاثة حروب خاسرة، وبيان أثرها على الواقع في مشاهد ساخرة ومفارقة، دون خطابية أو زعيق، بداية من حرب فلسطين حين يتم شحن المجندين فى عربة قطار البهائم والماشية إلى الحرب مباشرة، مع توافر الدعاوى الدينية للجهاد عبر توظيف السياسى للدينى من خلال شيخ القرية دون حساب منطق الواقع، والاستعداد الكافي للجيوش العربية. وكانت النتيجة ضياع فلسطين ورجوع آلاف من الجرحى والمصابين ومنهم “شداد” (الممثل “ساري النجار”) بقدم واحدة. هذا الاختيار الذكى لإعاقة جنود الحرب إشارة إلى أن الشعب لن يقف على قدميه مرة أخرى، فجراح وأخطاء الماضي أكبر من أن تُعالج بسهولة.
من المشاهد الدالة اقتحام عربة عسكرية القرية بجنود وعلم جديد، ثم سؤال العمدة عن هؤلاء فى إشارة لقفز ضباط الجيش على الحياة السياسة في مصر، ومع دخولهم نسمع أغنية ليلى مراد (على الإله القوى الاعتماد) فهم دخلوا أيضًا بآلتهم الدعائية الجبارة، لتعمية الشعب عن الحقيقة، وتزييف الواقع، ثم نراهم يأكلون في وليمة كاستعارة رمزية عن نهب خيرات مصر مستقبلًا.
الفجائية والفردية فى صناعة قرارات الأمة المصيرية من أجل الزعامة والدعاية للنظام إحدى سمات العهد الناصري، وكل النظم الشمولية مما كان له أثر كارثي على الوطن. نلاحظ علامات الدهشة والإعجاب على رواد مقهى القرية أثناء إعلان “عبد الناصر” قرار تأميم قناة السويس، بعدها مباشرة نشاهد هجوم طائرات العدوان الثلاثي، ودمار بيوت مدينة السويس سنة 1956.
تستمر آلة الدعاية العسكرية فى تضليل الشعب ممثلة فى بيانات المذيع “أحمد سعيد” الشهيرة عن سقوط طائرات العدو في حرب يونيو 1967، ثم خطاب التنحي وإعلان الزعيم تحمله المسؤولية. كأننا خسرنا مباراة كرة قدم وليس ضياع سيناء. هنا يبرز سؤال مُلح: من هو عدو الشعب الحقيقي؟ ولمن نوجه ثأرنا: لأخوتنا أم لسلطة مستبدة تقتل أبنائنا في حروب مجانية، ودعائية دون محاسبة؟
قهر المرأة
تعاني المرأة من قهر السلطة الذكورية بوصفها الحلقة الأضعف في المجتمع القبلي، وتتحكم أعراف وتقاليد موروثة فى مصير حياتها. نرى وضعية المرأة المقهورة عبر ثلاثة نماذج: الأول “رقية” المقموعة جسديًا، لا تستطيع تلبية رغباتها الجسدية، ولا تستطيع المطالبة بحقها في الطلاق من “شداد” العاجز جنسيًا، تختار طريق الغواية، فتكون نهايتها القتل حفاظًا على الشرف، وقضية الشرف في الوعي الجمعي الشعبي تأتى في مرتبة أعلى من القتل.
النموذج الثاني عاهرة القرية، أو الغازية المنتهكة جسديًا، تبحث عن الحب عبر جواب يقرؤه لها “صبري” من حبيب غائب، هى تريد الجنس الآتى من المحب لا من طالب المتعة. وكل من رقية والراقصة لديهما احتياج ناقص تبحثان عن إشباعه. والثالث هو الأم الثكلى “كفاية” ضحية أرث قبلي تتوارثه الأجيال مثل الأديان، كل آمالها تقتص لمقتل ابنها، وتعيش من أجل تحقيق هذا الحلم- الكابوس
يمكن اعتبار “هدية” التي جسدت دورها الممثلة “هدى هاني” النموذج المفارق، تنال ما تحلم به، الحب والزواج من “صبري”. وترك المخرج النهاية مفتوحة للسؤال عن مصير الجيل الجديد، هل سيهنأ بحياته أم تستمر دائرة الثأر والموت بلا نهاية؟
سمات أسلوبية
يتميز السيناريو بالاقتصاد والكثافة، وتتجلى لغة المشاعر، وتملأ الكاميرا الفراغ الحواري بالصمت، والإيماء، والموسيقى. تكثر اللقطات القريبة المعبرة عما يجيش داخل نفوس الأبطال من حالات الترقب، والانتظار، والحب. كل ذلك يُغلِّف السرد بمسحة شاعرية تثير الأسئلة بين المتفرج وذاته بأن ما يراه على الشاشة وراءه الكثير من الأفكار، والمعاني، والأحاسيس.

استخدام ثيمة التكرار من خلال لقطات معينة (تنظيف البندقية – عزق الأرض – جلوس الأم الثكلى)؛ ليؤكد معاني الترقب والانتظار، ودوران الزمن في حلقة مفرغة. كما يعطى شيوع اللون الأسود والقاتم في الملابس معنى الحداد الدائم لأبناء القرية، وطغيان الظلام في الكادرات يهيئ الجو المناسب لحضور شبح الموت، واستخدام الضباب يساهم في منح الجو الحلمي والأسطوري في مشاهد هروب “رقية” إلى الحقول؛ لإشباع رغبتها، فتحقيق الرغبة لا يتم إلا فى المخيلة.
يمزج المخرج بين الروائي والوثائقي؛ حتى تتلاشى الحدود بين النوعين، ويضفى كل منهما جمالياته على الآخر. يأخذ الروائي من الوثائقي شهادته على الواقع، ويعطيه خياله ورؤيته. هذه إحدى سمات أسلوبية القليوبي؛ لتكوين ذاكرة سينمائية حية تعيش فى وعى المتفرج. ولإيهام المتفرج بمرور الزمن يلجأ المخرج إلى كتابة خطابات السلطة مرورًا بحرب فلسطين “تبرعوا لحرب فلسطين” على حائط مشروخ وانتهاء بحرب67 “تبرعوا لفقراء الهند”؛ لإلهاء الشعب عن قضاياه الأساسية مع ثبات شعار “تبرعوا” بغية نهب الشعب تحت شعارات دينية وعاطفية، وهو يحقق من ذلك وظيفتين: جمالية، وفكرية.
رسم المخرج ملامح القرية المصرية فى الصعيد بعيدًا عن الصور النمطية القادمة من الأعمال التلفزيونية التقليدية، والأحكام المُسبَّقة من خلال عرض التفاصيل الدقيقة لعادات وتقاليد القرية مثل طقوس الأفراح، ورقص الصبايا، وزفة العريس، ورش الملح، وطقس شرب الشاي لدى الفلاحين، وتقديس الموت. وقد أعطى ذلك خصوصية وحيوية لأحداث الفيلم، وأضفى على الأبطال واقعية، وحولهم إلى شخصيات من لحم ودم.
تعتبر موسيقى “راجح داوود” جنائزية الطابع بطلًا من أبطال العمل، وليست خلفية، أو عنصرًا للزخرفة. تقوم بدور بنائي في السرد الدرامي، تُذكِّر “آدم” بثأره البائت. كأنها صوت داخلي، وتعلق على الحوادث المأساوية، وتعطى المتفرج شحنة شعورية حزينة، فلا يمكن أن يخرج من الفيلم دون أن تعلق في ذهنه، وتمس روحه من خلال توزيع موسيقى أوركسترالي يصحبه نواح ذكوري.
كان الممثل “هشام عبد الحميد” متألقًا، ومقنعًا في تجسيده لدور “آدم” بنظرات عينيه، وتلوين صوته، وأعطت تعبيراته زخمًا وتجسيدًا حيًا لأب مكلوم. كذلك الممثلة المخضرمة “سوسن بدر” في دور الأم “كفاية”، التي أثبتت أنها تستطيع القيام بمختلف الأدوار، والشاب “أحمد عزمي” في دور “صبري” بتلقائيته وعفويته، والممثل الموهوب “ساري النجار” الذى فضل الابتعاد عن العمل السينمائي، وبرعت “جيهان فضل” في دور “رقية” بجمالها وعذابها الداخلي. أما اختيار “حسن حسنى” فأرى أنه لم يكن مناسبًا، لأن المخرج انحاز للنجم على حساب الدور، فبعد مرور عشرين عامًا لم نلحظ تغيرًا كبيرًا فى ملامحه أو جسده. بقية العناصر من تصوير، وديكور، ومونتاج كانت فى قمة الجمال والحرفية.