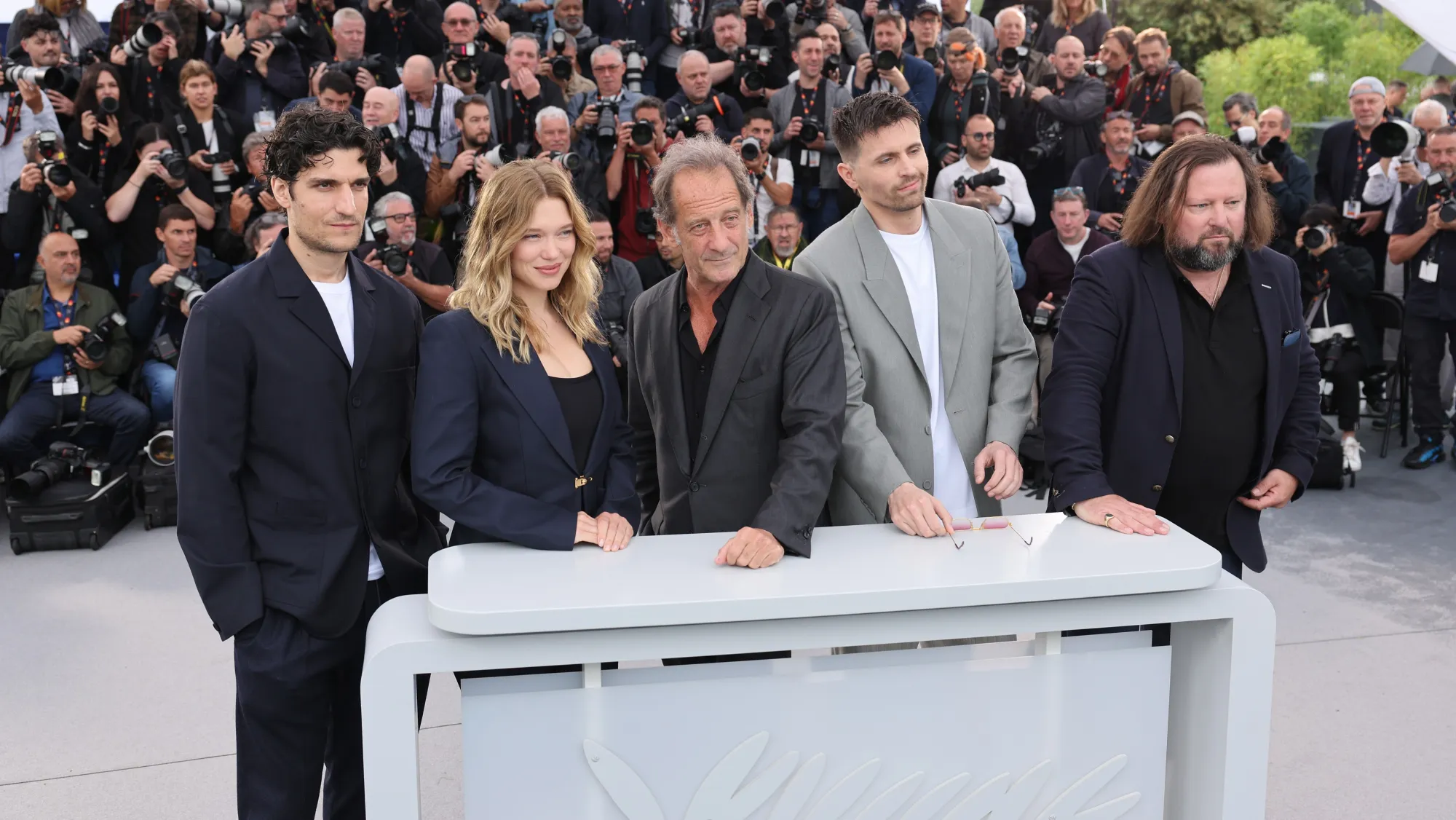“آدم”.. حرمان وكبرياء وأغنية

فيلم “آدم” عمل مصطبغ بذاتية لافتة وتخترقه طراوة ودهشة، وهو يخلو من ارتباك البدايات بالرغم من أنه الفيلم الطويل الأول للمخرجة المغربية مريم التوزاني بعد فيلمين تخييلين قصيرين هما” الليلة الأخيرة” (2011) و”آية والبحر” (2015) وفيلم وثائقي قصير بعنوان “جلدي القديم” (2014). وقد اختارت المخرجة في هذه الأفلام القصيرة أن تتبنى رؤية مسؤولة جماليا وفكريا، وأن تقترب من بعض المواضيع الحارقة مثل الدعارة واستغلال الأطفال، لكن دون صراخ وهتافات، ودون تقديم تنازلات فنية.
يتوزع فيلم “آدم” على ثلاث حركات وكأن الأمر يتعلق بقطعة موسيقية:
الحركة الأولى هي حركة خطية تصل أحيانا حد الرتابة، ونتعرف فيها على الشخصيات الرئيسة في الفيلم، ونعرف كيف تقاطع مصيرا إمرأتين تواجهان العالم لوحدهما وجمعت بينهما صداقة لم تكن من “أول نظرة”. يتعلق الأمر بسامية الشابة ذات الملامح الغامضة والمتعبة.
لا ندري من أين أتت ولا ما الذي تريده. تلاحقها الكاميرا في لقطات مقربة وهي تائهة بحواري مدينة الدار البيضاء العتيقة ببطن منتفخة جراء حمل يبدو أنه غير مرغوب فيه، أو وهي تطرق الأبواب طالبة “ضيف الله” وعارضة خدماتها.
وقد رفضت عبلة في البداية أن تستضيفها بمنزلها لولا التدخل الحاسم لوردة التي لم تكمل بعد ربيعها الثامن، مما جعل من هذه الطفلة الوديعة طوال الفيلم عامل تلطيف، هي التي تشع منها طاقة إيجابية لذيذة وتعطي الكثير من المعنى لحياة أمها عبلة المرأة شحيحة الكلام وذات التعامل الصارم والقاسي، والتي تبيع فطائر وحلويات وتوفرها بأثمنة متواضعة لأهل الحي البسطاء والمنهكين وتطل عليهم وعلى العالم من منصة متجر صغير ملحق بمنزلها، وبابه هو ما يمنحنا، عبر عمليات الفتح والإغلاق المتكررة، فكرة عن مرور الزمن وإيقاعه. ويبدو أن الحياة لم تكن رحيمة مع عبلة مما جعلها تحتاط من الناس ومن الآتي وتفضل أن تعيش في عزلة تتعهد ابنتها واحتياجاتها وذكرياتها. وما يكسر أحيانا هذه العزلة عبور السليماني الشاب المغرم بها والذي يعرض عليها حيويته وحبه بكل سخاء وطيبوبة.
الحركة الثانية في الفيلم، الذي أهدته المخرجة لأمها، تتميز بأنها ذات نبرة فرح وتوثب ورغبة في إحداث بعض الضوضاء، وفيها نلاحظ أن العلاقة بين المرأتين أصبحت قوية وتوطدت بشكل كبير، وأصبحت سامية مقيمة بالمنزل وشريكة في صنع الفطائر والحلويات، وبدأت تأخذ المبادرة تلو الأخرى، وتعرفت على الحي، كما تعرضت لتعليقات جارحة من بعض النساء، واستوقفتها حالات تعاطف غير منتظرة مع وضعيتها كحامل مثل تعاطف صاحب الفرن الودود. ووضعها غير المستقر لم يمنعها من أن تسجل استعدادها للاحتجاج حينما اكتشفت أن الدقيق الذي سلم لها لصنع الفطائر هو دقيق مغشوش. وأجمل لحظات الفيلم تمر في المطبخ وما يستتبعه من متع واستيهامات، المطبخ باعتباره مختبرا سريا وسحريا يبهر بمحتوياته وتوابله التي تفاجئك دوما بمذاقات جديدة تتحول بدورها إلى أحاسيس لذيذة وغامضة تغير رؤية الحاضرين للوجود ولو للحظات. أما عبلة فأصبحت أكثر رقة وأكثر استعدادا للتواصل. وهكذا ارتبطت المرأتين ارتباطا وثيقا مبدأه الأساس هو الإقتسام والتضامن. وهذه الصداقة المتواطئة التي جمعت بين المرأتين تشبه العلاقة التي جمعت بين “ثيلما و لويز”، في الفيلم الذي يحمل نفس الإسم، وكأن فيلم “آدم” هو صيغة ملطفة من الفيلم الأمريكي المذكور الذي وقعه المخرج ريدلي سكوت سنة 1991حيث تلتقي الشخصيات النسائية في الفيلمين في مواجهتهما لقسوة الحياة وتقلباتها وأنانية الرجال أو غيابهم وفي الإبداع لتدبير رتابة اليومي وفجائعه.

وبدأ بطن سامية يزداد انتفاخا مما كان يثير فضول الطفلة وردة فتزداد تعلقا بهذه الضيفة الاستثنائية التي عثرت بالصدفة على شريط قديم للمطربة وردة فشغلته وبدأت ترقص بغنج وحسية لنكتشف نحن جاذبيتها وأنوثتها المحتجبة، إلا أن وردة نبهتها إلى أن الأمر قد يغضب أمها التي توقفت عن سماع أغنية “بتونس بيك/ وجودك يؤنسني” منذ وفاة زوجها البحار. غير أن سامية اختارت أن تفرض على عبلة سماع الأغنية وجعلتها، بإصرار يكاد يصل حد العنف، وعلى أن ترقص على نغمات تلك الأغنية وجعلتها تشعر بنشوة كادت تصل حد الرعشة. وتذكرت عبلة برقصها ذاك بأنها أنثى، فانفردت بنفسها وتخففت من ثيابها وتأملت عريها ثم نامت مثل نومة الجنين. وفي اليوم الموالي، وكأنها انبعثت من رمادها، تزينت وكحلت عينيها وأعطتنا الإنطباع بأنها تصالحت مع نفسها وجسدها. وكان استقبالها ذلك الصباح للسليماني الطيب والصبور استقبالا مغايرا ومحملا بوعد ما.
والفيلم يخترقه ملمح إيروتيكي وحميمي بدا في لحظات الرقص وبدا كذلك، وبفنية عالية ، حين إعداد عجين الفطائر ببهجة وفرح من طرف نساء الفيلم عبلة وسامية ووردة مما يذكرنا بفيلم “شوكولاته” (2000) حيث تأتي الشخصية الرئيسية في هذا الفيلم، التي أدت دورها برهافة وروعة الممثلة جولييت بينوش، هي الأخرى من لا مكان، إلى قرية إيطالية محافظة، فتخرق السكينة السائدة وتزعزع توازنا قائما بسلاحين: عنادها وصنعها لشوكولاتة فائقة اللذة، كما أن حكايتها تلتقي مع حكاية “آدم” في أن لديها سرا ما، وابنة لا يعرف من هو أبوها ، وفي أن هنالك رجل غير عاد يقف إلى جانبها ويساندها. ومن البين أن المطبخ يمنح احساسا بالدفء والأمان، وذلك ما يبدو للعيان حين إعداد سامية لحلوى العيد التي أقبل أهل الحي على شرائها بلهفة، واقتسم الجميع ضحكا صافيا وهم يطلون على كبش غاضب تمرد على صاحبته.

وفي مشهد مجال ضد مجال، تسر المرأتان إلى بعضهما البعض، وإلينا كذلك، بما تكنان في صدريهما من حسرة ولوعة، وحكت عبلة عن زوجها الذي كان كريما معها وعن رحيله المبكر و عن عدم تقبلها للميز الذي يمارس ضد النساء إذ يمنعن حتى من “الحق في الذهاب في جنازة من يحبن لتوديعهم الوداع الأخير” لتجيبها سامية بأن”أشياء قليلة هي في ملكيتنا”، ثم تعترف بمرارة “أريد لإبني أن يكون له مستقبل مع أسرة محترمة” ، فسامية التي تركت أسرتها هربا من ضغط اجتماعي أكيد والتي لا نعرف للرجل الذي كانت مرتبطة اسما ولا ملامح تريد أن تجنب ابنها وصمة لم يخترها. ثم أتاها المخاض فبدأت تصرخ وتعلن إحساسها بالألم فهيمن الترقب وانتظار المجهول.
في الحركة الثالثة التي نشعر فيها، كمتلقين، بهبوط مفاجيء في الإيقاع، نصدم بأن سامية لم تستسغ، بعد الولادة، وجود رضيعها، ورفضت إرضاعه والعناية به، وكانت توجه له نظرات فيها قسوة وندم . وسرعان ما تصالحت معه وبدأت تشعر بانجذاب نحوه، فأخذت تتحسس أصابع يديه ورجليه الصغيرة واللدنة في لقطات مقربة وتقبلها وتردد المرة تلو الأخرى: “الخطأ خطأي، وأنا لا أريدك أن تتعذب، فمعي مصيرك محسوم سلفا”. ثم قررت أن تغادر المنزل نحو وجهة لا نعلمها كما أتت في بداية الفيلم من مكان هو أيضا مجهول، ولم نتبين ما كان قرارها وهي توصد الباب وتغادر دون أن تخبر صديقتها عبلة. كل ما نعلمه هو أن إمرأة شجاعة تحلم بأن تعيش عزيزة النفس دون أن تفرط في رفقة كائن جاءت به إلى هذا العالم بعد لحظة عشق أو لحظة ضعف، وأنها تنظر بعزيمة نحو مستقبل لا تعرف تفاصيله ومنعطفاته. كما أن إمرأة أخرى تبدع وتكابر بكبرياء لتوفر لإبنتها حياة كريمة بعد أن رحل الأب مبكرا وظلت راضية بأداء مهمة مزدوجة، مهمة الأم ومهمة الأب في مجتمع مغربي منهك وفاقد للبوصلة ولا يحترم النساء بالقدر الذي يتوجب.
إن فيلم “آدم” هو مديح للأمومة، وللعطاء دون انتظار المقابل. وهو ليس فيلما كئيبا ولا متجهما ولا يبحث عن تعاطف أو شفقة. هو عمل متقشف لكنه غني بالعواطف والإيماءات، وشاعريته الخفية تجعلنا ننشد إلى الوقائع وإلى الشخصيات. ومثلما هو حال عنوانه، فحكاية فيلم “آدم” هي عابرة للمجتمعات والثقافات، وهو يصور حالات حرمان وأسى وهشاشة ، ويدين بهدوء وصوت خافت عنف الرجال وأنانيتهم، و فيه يكاد يغيب المجتمع والعالم الخارجي لتقترب الكاميرا من الشخصيات وانفعالاتها وحالات سكونها و صخبها، وهو يقدم لنا درسا في حب الحياة و الإقبال عليها وفي التدليل على المهارات التشخيصية والفنية لممثلتين رائعتين (لبنى أزابال ونسرين الراضي) ولممثل قوي هو عزيز الحطاب ولطفلة في عمر الورود. هو فيلم يقنعنا بيسر أن المرأة، كما قال الشاعر أراغون ذات مرة، هي مستقبل الرجل، وهي مستقبل الإنسانية كذلك.