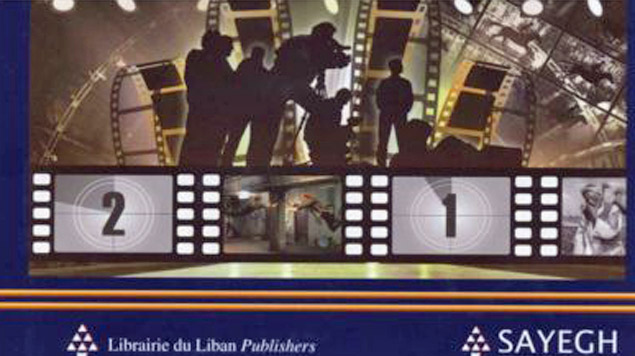“شريط الذكريات” الحب والموت وتدمير السينما!

بين زمنين
انتهت مرحلة الذهاب إلى السينما مع الأسرة بحلول منتصف التسعينيات لتطوي صفحة الشغف الأولى والتشوق لرؤية عمود الضوء المزرق يخرج من شباك صالة العرض ليضعنا امام احلام الأخرين على الشاشة.
ربما كانت أم بواقي وآثار تلك المرحلة هو الاستئناس النفسي الكامل والشعور بالهدوء العضوي وراحة الذهن والتنفس بعمق وانتظام داخل السينما.
هذا الشعور لم يفارقني منذ كنت صغيرا حتى الآن. وقد جلست في عشرات من دور العرض وفي بلاد كثيرة حيث ظلت السينمابالنسبة لي هي براح للدعة ومساحة لاستعادة ثقتي بأن العالم لا يزال يصلح للحياة فيه طالما أن هناك افلاما يمكن أن تمنحنا القدرة على الشعر والمقاومة واختراع السماء.
أذكر أن أخر فيلمين ذهبت لمشاهدتهما مع الأسرة كنت في حوالى السادسة عشرة من العمر وكان الفيلمان هما الامريكي”القناع” الذي اطلق نجومية جيم كاري، والمصري “المهاجر” ليوسف شاهين، وكلا الفيلمين شاهدتهما مع الأسرة في سينما “نورماندي” الشتوي بمصر الجديدة وكان يطلق عليها الشتوي للتفرقة بينها وبين “نورماندي” الصيفي التي تلتصق بها.
كانت سينما شديدة الرقي آنذاك، وقد فرغوا للتو من تجديدها، وكنا نذهب للجلوس في الكافيتريا الخاصة بها في الدور العلوي التي تطل على شارع الاهرام، وكانت القاهرة لا تزال تحتفظ بقليل من بقايا الجمال الشكلي والأخلاقي والسلوكي ولم تكن قد تحولت بعد إلى مدينة تسكنها الفوضى وافلام السبكي وتامر وحسني ومحمد سعد.
لست أذكر سعر تناول المشروبات في كافيتريا السينما لأن أبي رحمة الله هو الذي كان يدفع الحساب، ولكني لم اره يتذمر وقتها او يشعر ان السعر مبالغ فيه..
كان كل شئ لا يزال في حدود المعقول ولم تكن السينما “السياحية” التي ابتدعتها المولات او”التسولية” التي تجدها في سينمات وسط البلد الآن قد سادت، فلا الأسعار ولا طريقة الدعوة لتناول المشروبات في الكافيتريا ولا أسلوب الخدمة كان مزعجا او يسبب القلق والتوتر مثل الأن.. فسعر كيس الفشار مع علبة البيبسي او حلوى غزل البنات اصبحت بسعر مواز يكاد يفوق سعر تذكرة السينما نفسه في سينما المولات.
اما في سينمات وسط البلد فهناك حالة فرك اليد المستمرة من قبل كل العاملين بداية من قاطع التذاكر الذي لا يفتأ يقول لك “كل سنة وانت طيب يا بيه” ثم يعطيك الباقي ناقص 5 جنيهات ويقول لك: كويس كده بقى دي الحلاوة بتاعتنا – وكأن دخول السينما يوازي النجاح في الثانوية العامة مثلا- رغم ان سعر التذكرة نفسه 15 جنيها وبعد مفاوضات يترك لك ثلاثة جنيهات بالعافية ثم تجد اربعة اشخاص ينتظرونك منذ دخولك من باب دار العرض الخارجي فينظر احدهم في التذكرة ويقول لك اتفضل معايا ثم يسير بك خطوتين ويقول كل سنة وانت طيب- بدون اي مناسبة تستحق المعايدة- فتعطيه البقشيش ظنا منك انه البلاسير المسئول فتجده يسلم تذاكرك لشخص اخر.
ويتكرر معه نفس السيناريو إلى ان تصل في النهاية إلى البلاسير الفعلي فتجده يقول لك أخيرا بعد ان تكون قد انفقت ما يوازي ثلث ثمن التذكرة في سبيل الوصول لمقعدك (اقعد مكان ما تحب يا بيه!! )..
لا افتأ اقارن بين زمنين طوال الوقت رغم ان السينما في تلك الفترة “منتصف التسعينيات” كانت تعاني من استمرار لحالة الركود والكساد التي بدأت منذ منتصف السبعينيات واوائل الثمانينيات مع الانهيار التام لدور الدولة في السينما وسيطرة فكر المقاولات عليها ثم حالة الانحدار الثقافي والوجداني التي تلت فترة الانفتاح الاقتصادي مع صعود طبقات جديدة لا تعني لها الثقافة او وجدانيات العمل الفني اي شئ..
ولم تكن قد انتعشت صناعة السينما بعد انطلاق الموجة الكوميدية عام 97 بفيلم المقاولات الشهير “اسماعيلية رايح جاي”، وأصبحت دور العرض تعرض ما يقارب العشرين فيلما مصريا في السنة ناهيك عما يزيد عن 100 فيلم أجنبي سنويا فليس هناك إذن مبرر لهذا التسول في سينمات وسط البلد او المبالغة الغريبة في سعر اي شئ داخل سينما المولات.
تذكرة للجنة
في عام 1993 كانت المرة الاولى التي اذهب فيها إلى السينما مع اصدقائي.. كنت في الصف الاول الثانوي وذهبت لمشاهدة فيلم last action heroمن بطولة ارنولد شوارزنيجر والذي كان يعرض في القاهرة باسم “بطل المعركة الأخيرة” أو “البطل الخارق” لا أذكر بالتحديد.
كانت تلك المرة الاولى التي تسمح لي فيها أمي بالذهاب إلى السينما بدون الأسرة ولكن في صحبة اصدقاء.. كان احدهم زميل لي في المدرسة والأخر قريبه وكان سفر ابي المستمر يجعلها صاحبة القرار. وبما ان الام بطبعها شخصية انفعالية فكانت مثل هذه القرارات تحتاج إلى ثبات انفعالي وتركيز في طريقة العرض أو الطلب من جانبي للحصول علي قرار بالإيجاب.
وذهبنا إلى سينما ريفولي وكانت تعرض افلاما اجنبية وقتها قبل ان تتحول لتصبح مرتعا لجمهور سينما الدرجة الثالثة التي اختفت واصبحت ريفولي وريثة هذا النوع من جمهور الافلام المصرية.

كنت اشعر بسعادة شديدة واتوقع ان اشاهد فيلما جيدا فقد كنت لا ازال في مرحلة الوقوع تحت تأثير سينما الأكشن الأمريكية بسبب النوعية التي كانت منتشرة في نوادي الفيديو.
وبينما نقوم بشراء التذاكر وفي انتظار الدخول اذا برجل يقترب منا ويبدأ في تجاذب أطراف الحديث معنا.. سألنا عن الفيلم ولماذا قررنا دخوله وهل هو فيلم جيد!
وبحكم كوني اكثرهم طلاقة في الحديث واكثرهم ثقافة سينمائيا فقد رحت اتحدث معه عن الفيلم من واقع التريلر الذي كنت قد شاهدته في فيلم سابق دخلته مع اسرتي.
ووجدت ان زميلي وقريبة يؤثران الصمت وينظران للرجل بريبة. وبمجرد ابتعاد الرجل اذا بقريب زميلي وهو فتى في مثل عمرنا يقول: مش بحب اللي يجي يتكلم مع ناس ميعرفهمش كده!
كانت الجملة كفيلة بأن أفهم مقصده. ووجدتني اسأل نفسي ما الذي يدعو رجلا لتجاذب اطراف الحديث مع ثلاثة فتيان صغار في الصف الأول الثانوي وعلى باب قاعة مظلمة يمكن ان تتوه في ظلامها تفاصيل سرية او جانبية كثيرة.
اسقط في يدي وشعرت بتوجس وخوف شديد.. كانت امي تحذرني دائما من مغبة الحديث مع الغرباء وكانت قد روت لي عن حادثة ظلت عالقة في خيالي تخص احد اطفال العائلة عندما كادت امرأتين في سيارة ان تخطفانه بسبب انه تحدث معهم وركب السيارة..
الخوف من المجهول
ووجدتني بحكم المخيلة المُسيطرة والموقف “الخطير” افقد رغبتي في الدخول إلى السينما او مشاهدة الفيلم وتلبسني شعور بأنني سوف اتعرض لمكروه الليلة فالرجل تحدث معي انا دون صُحبتي وانا الذي شجعته على تبادل الحديث بمعلوماتي السنيمائية ظنا مني – بحكم الرغبة في اظهار التفوق لدى المراهقين- أنني أنال إعجابه وتعجبه من معارفي.
ودخلنا إلى السينما وقررت الجلوس في المنتصف ما بين زميلي وقريبه لتأمين حدودي الجسدية رغم ان الرجل كان قد اختفى تماما وسط الزحام..
كانت احداث الفيلم تدور حول فتى صغير يعشق احد ابطال سلسلة افلام شهيرة ويقضي جل وقته في احدى دور العرض المهجورة يشاهد الأفلام بمفرده ولا يمل منها ولم يكن له صديق سوى عامل العرض العجوز الذي هو صاحب ومدير السينما وبلاسيرها في نفس الوقت.. وذات ليلة يعطيه العجوز تذكرة ذهبية يقول له انه حصل عليها من هوديني الساحر الامريكي الشهير وانها تذكرة سحرية!
واثناء مشاهد الفيلم يكتشف الفتى أن التذكرة تمكنه من الدخول إلى عالم الفيلم نفسه.. يا اللهي.. انها تذكرة للجنة بالنسبة لي ..هل يمكن أن يتمكن المرء يوما من الدخول إلى عالم الافلام والاختفاء فيه!
(اريد منكم ان تتذكروا هذه الحادثة لانني سوف اعود إليها في نهاية هذه الذكريات وسوف ترسم جزءا من تصوري عن العالم الاخر وحياة ما بعد الحساب).
تذكرت هذه اللحظات وأنا أشاهد فيلم “بحب السيما” تأليف هاني فوزي وإخراج اسامة فوزي، في المشهد الشهير الذي يتخيل فيه الطفل يوسف أن السينما هي الجنة، وان قاطعي التذاكر والبلاسيرات هم ملائكة الرب الطيبون.
نعود إلى الرجل الذي افسد علي اول مرة اذهب فيها إلى السينما مع اصدقائي وافسد علي الاستغراق في مشاهدة هذا الفيلم الممتع وكانت الأحداث كلما اقتربت من النهاية كلما شعرت ان القضاء قد أصبح أكثر قربا وان الرجل سوف ينتظرني على باب السينما ليأخذني من بين اصدقائي في طريق “الخطيئة” و”المجهول”!
في الحقيقة فإن سبب افساد تلك الامسية كانت جملة قريب زميلي التي لولاها لما تنبهت لفكرة الحديث مع الرجل او الخوف من نيته تجاهي.. ربما كانت طبيعة زميلي وقريبه الفلاحية التي تتوجس من الغرباء على عكسي انا ابن المدينة المتفتح الذي تربى في النوادي.
المشكلة انني بعد العودة للبيت رويت الحادثة لامي من باب التندر او تفريغ اللحظة.. فإذ بها تنفعل وتقول لي ان قريب زميلي على حق وانني اخطأت بالحديث مع الرجل وان الله سلم وانني يجب ان اكون اكثر حذرا ثم لا تجد ما تختم به ذلك الحديث التحذيري سوى إعادة رواية الحادثة التي كادوا يفقدون بسببها طفلا من العائلة لان امراتين حاولا ان يخطفانه في سيارة.
وبما أن الحادثة كانت غالبا خيالية من وحي غريزة الأمومة الدفاعية كان من السهل ان تعتبر أن الذهاب إلى السينما بمفردي مثل ركوب سيارة مع غرباء.
الموت في السينما
لا اذكر متى كانت اول مرة اذهب فيها إلى السينما بمفردي ربما كان ذلك في عام 1995 وكان الفيلم هو “قشر البندق” من اخراج خيري بشارة وبطولة محمود ياسين الذي انتجه من اجل عيون ابنته رانيا وشاركها البطولة لاول مرة المطرب الليبي ذائع الصيت وقتها حميد الشاعري ومن كتابة مدحت العدل عن فكرة يقال انها مستوحاة من فيلم انهم يقتلون الجياد.
شاهدت الفيلم في سينما روكسي حفلة 3 ظهرا (هل كانت هذه هي المرة الأولى أم أن هناك مرة أخرى لا اذكرها!).
المهم ان فكرة الذهاب للسينما بمفردي كانت مغامرة بكل المقاييس لأن هذا معناه أنني يجب أن أقوم بتحضير سيناريو كامل عن تواجدي في مكان أخر لثلاث ساعات.. فأمي كما ذكرت كانت تمنعني من الذهاب بمفردي للسينما منذ دخلت المرحلة الثانوية ولم تكن تسمح لي بالذهاب إلا إذا قلت لها إنني ذاهب مع اصدقائي، وكانت موجة الارهاب تضرب القاهرة بشكل مفزع وكانت القنابل المسمارية قد حصدت العشرات طوال سنوات فلا تدري متى او اين يمكن ان تنفجر فيك قنبلة موقوتة!
وكانت امي في بعض الاحيان ترفض بشدة ذهابي للسينما من الاساس خوفا من تلك الحوادث. واذكر وقتها ان هناك قانونا صدر او امرا بوليسيا ما بعدم السماح لاحد بالخروج اثناء العرض.. وكانت هذه التعليمات تجعلني دائما افكر: هل يستحق تدمير السينما ان يقوم الأرهابي”بعملية استشهادية”؟
بمعنى هل يمكن أن يدخل ليضع القنبلة وينتظر معنا مشاهدة الفيلم حتى تنفجر القنبلة وتقبض الملائكة روحه إلى الجنة بينما يرسلنا الله إلى الجحيم عقابا لنا على مشاهدتنا الأفلام (هل تذكرون المشهد الرائع لتخويف الطفل من السينما في بحب السيما).
ماذا إذن لو أعجب ذلك الارهابي الفيلم الذي سيتسلى حتما بمشاهدته حتى يحين وقت “استشهاده” هل سيشك حينها في جدوى العملية وانها ربما حق ولكن يراد به باطل او باطل يراد به باطل، أم ستصيبة الريبة من أن الملائكة سوف تسوقه معنا إلى الدرك الأسفل من النار حيث يرقد صناع السينما وعشاقها من وجهة نظره!!
عاد إلى هذا الهاجس اثناء مشاهدة فيلم “كباريه” من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف احمد عبد الله، في المشهد الاخير عندما حاول الأرهابي فتحي عبد الوهاب ان يمنع زميله من تفجير القنبلة لانه اكتشف ان الكباريه به نماذج انسانية لا تستحق كلها ان تغتال بهذه الطريقة.. وطبعا القياس هنا مع الفارق.
كانت تلك الخواطر عن الإرهاب والانتحاريين تعبر رأسي في كل مرة اذهب فيها للسينما، وكنت اتصور حال أمي وهي تشاهد نشرة الأخبار وترى مشاهد حية لاحتراق سينما روكسي – التي كانت سينماي المفضلة وقتها- بعد انفجار قنبلة ارهابية بها ومصرع واصابة العشرات جراء الانفجار..
كان هذا المشهد التخيلي المفزع هو ما يجبرني دائما على الانصياع لأمرها بعدم الذهاب بمفردي دون علمها إلى السينما وذلك خوفا عليها من أن تفقد اثري للأبد.. وليس خوفا من الموت في السينما.
(المشكلة انك لا تدري لو انك مت في السينما الآن فأي فيلم سوف تذهب إليه روحك ؟! هذا يتوقف بالطبع على طبيعة الفيلم المعروض في السينما وقتها.. وانت بحكم عملك كناقد تشاهد افلاما كثيرة رديئة وعفنة.. تصور لو انه فيلم من افلام سعد الصغير او بلال فضل او تامر حسني او هاني جرجس فوزي.. ساعتها لن يكون الجحيم هو الاخرون.. بل افلام هؤلاء).